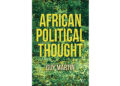عرض: محمد عبد العزيز الهواري
معلومات الكتاب:
تاريخ النشر: 2011م.
جهة النشر: المركز العربي للدراسات الإنسانية
مقاس الكتاب: 14×21.
المؤلفان: د. حسن الحاج علي عميد كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، جامعة الخرطوم. ورئيس تحرير مجلة دراسات الإسلام والعالم المعاصر.
و أ. د. حمدي عبد الرحمن أستاذ العلوم السياسية في جامعتي زايد والقاهرة.
ينقسم الكتاب إلى جزأين:
الجـزء الأول: من الكتاب «جنوب السودان.. الواقـع الاجتماعي والتفاعل السياسي»
د. حسن الحاج علي
يهتم هذا الجزء بتحليل أوضاع جنوب السـودان المختلفة: الجغرافية والثقافية والسياسية, ويركّز بشكل أساسي في التطورات التي مرّت بها قضية الجنوب في العقدين الماضيين؛ دون إغفال البعد التاريخي المهم في توضيح صورة الحاضر.
ويهدف الكاتب إلى توضيح الرؤية الفكرية والسياسية للحركة الشعبية لتحرير السودان، وتطوّر أسلوب عملها العسكري والسياسي.
استخدم الحاج المنهجين التاريخي والتحليلي في تحليل الأوضاع السياسية والاجتماعية في جنوب السودان.
يركّز المنهج التاريخي في استخدام بيانات أوليّة للإجابة عن أسئلة محدّدة, وتشتمل مصادر البيانات على السجلات الديموغرافية، والمقالات الصحافية، والمذكّرات والوثائق الحكومية.
وأحد الطرق في طرح الأسئلة عن قضايا معاصرة هو النظر في كيفية تطوّر جوانب مهمة من المجتمع المعاصر.
وتتضمن الأسئلة المطروحة في هذا البحث ما يأتي:
ما طبيعة التكوين الاجتماعي والسياسي لمجتمع جنوب السودان؟
وما العوامل التي أثّرت في تطوره؟
وما الأهداف السياسية التي تود النخب السياسية الجنوبية تحقيقها؟
وهل تغيّرت الأهداف أو تغيّرت الوسائل؟ ولماذا؟
بجانب المنهج التاريخي؛ قام البحث باستخدام المنهج التحليلي بهدف تفسير الوقائع السياسية والاجتماعية, ويتحقق ذلك عبـر التدبّر في التوجهات القيمية للفاعلين الأساسيين، ومعرفة أهدافهم السياسية، وتفكيك الظواهر الكلية لفهم مدلولاتها وتفسيرها، والربط والمقارنة بين الجزئيات عبر حقب سياسية مختلفة.
ويعتقد الكاتب أن المنهجين مناسبان لتحليل المشكلة البحثية المتعلقة بجنوب السودان المتمثلة في الأسئلة المطروحة أعلاه؛ من حيث القدرة على الإدراك والفهم والتفسير.
ينقسم الباب إلى ثلاثة فصول وكل فصل يتضمن العديد من الأبحاث.
وحول جغرافية جنوب السودان:
بيّن د. الحاج أن جنوب السودان يقع تحت خط عرض 13 درجة، وأنه يتكوَّن من عشر ولايات، ويبلغ عدد سكانه, وفقاً للتعداد السكاني الذي أُجري في عام 2008م, نحو ثمانية ملايين نسمة (8,260,000)، أي نحو 21% من سكان السودان.
وعلى الرغم من التنوّع القائم بين شمال السودان وجنوبه؛ فإن التنوع الموجود داخل جنوب السودان أكبر. وهناك العديد من اللغات الجنوبية المستخدمة؛ الأمر الذي جعل لهجة عربية خاصة عُرفت بـ «عربي جوبا» لغة التخاطب العامة، وخصوصاً في المدن الكبرى.
لا يوجد إحصاء دقيق لانتشار الإسلام والمسيحية في جنوب السودان، لكن الواضح أن أغلبية السكان يعتنقون ديانات محلية، وتنتشر المسيحية بين النُّخَب المتعلمة، ويعود ذلك للدور الكبير الذي قامت به المدارس التابعة للبعثات التنصيرية، وذكر المؤلف في الكتاب بعض الأنشطة التنصيرية، ومدى الوجود الإسلامي في الجنوب.
وعن التيارات والأحزاب السياسية في جنوب السودان:
أكّد الحاج أن الإدارة الاستعمارية، وبعد مضي أقل من عقدين من الاحتلال، قامت بوضع اللبنات الأولى لعزل جنوب السودان عن شماله، أو ما عُرف بالسياسة الجنوبية.
كما أشار الكاتب لمعانة القوى السياسية الجنوبية التفتت والانقسام؛ الأمر الذي جعل عدداً من التنظيمات السياسية الجنوبية لا تعمِّر طويلاً، فقد ظهر العديد من التنظيمات الجنوبية، ثم اختفت بعد فترة وجيزة من إنشائها, ويعود السبب في ذلك إلى الصراعات الشخصية بين النخب والتنافس الإثني، وطبيعة المعركة التي تخوضها تلك التنظيمات ضد الحكومة.
وفي الفصل الأخير:
تحدث الحاج عن الحركة الشعبية وقيادة الحرب على المركز، فبيّن أن نشأة الحركة الشعبية لتحرير السودان ترجع إلى مايو 1983م عندما تمرّدت الكتيبة (105) في مدينة بور، وكانت بقيادة الرائد كاربينو كوانين، وسيطر المتمردون على المدينة، فقرر مجلس الدفاع الوطني إعادة السيطرة على المدينة بالقوة، وقامت القوات الحكومية بشن هجوم تمكنت بعده من السيطرة على المدينة، مما اضطر الكتيبة المتمردة إلى اللجوء لإثيوبيا.
وفي خاتمة الدراسة:
يتضّح من اتفاقيات السلام الرئيسة التي وُقّعت بين الحكومات السودانية والحركات الجنوبية المتمردة؛ أنها تمّت بمساعدة خارجية, وتشير الدراسة بصورة خاصة لاتفاقيتي «أديس أبابا» في عام 1972م، و «اتفاقية نيفاشا» في عام 2005م، وكما أوضحت الدراسة؛ فقد كان دور إثيوبيا ومجلس الكنائس العالمي كبيراً في الاتفاق الأول، بينما كان لشركاء الإيجاد – الدول الغربية وبخاصة الولايات المتحدة – الدور الرئيس في الوصول إلى الاتفاق الثاني, وقد غابت الدول العربية والإسلامية عن المسعيين!
ومعنى غياب الدول العربية انفراد الغرب بالتأثير في الشأن السوداني, وجاءت «اتفاقية نيفاشا» في وقت تشهد فيه المنطقة العربية الإسلامية ضعفاً عامّاً لم تظهر ملامحه في السودان فحسب، بل كذلك في فلسطين والعراق.
ويبدو أن جنوب السودان، وكما توحي المؤشرات الحالية، يسير بخطى راسخة نحو الانفصال, فالمتتبع للحركة السياسية الجنوبية يلاحظ أنها قد بدأت في طرح أهدافها بصورة تدريجية, ومع التحولات المحلية والإقليمية والعالمية؛ بدأ صراع الهويات في التنامي في السودان, وتبدّى هذا الصراع في أوضح حالاته في مشروعين متنافسين: مشروع السودان الجديد الإفريقي السمات العلماني التوجه، وسودان التوجّه الإسلامي.
جاءت اتفاقية السلام لتعطي المشروعين فرصة أعوام ستة للتعايش عبر فكرة «دولة ونظامين», كل المؤشرات تفيد بأن النخب الحاكمة لم تنجح حتى الآن في تحقيق التعايش، فها هو ذا جنوب السودان يضع اللبنات الأولى لمشروع دولة على وشك القيام.
الجـزء الثاني من الكتاب: «التداعيات الجيوسياسية على الأمة الإسلامية»:
أ. د. حمدي عبد الرحمن
أوضح الكاتب أنه في التاسع من يناير عام 2005م وقَّعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان «اتفاق نيفاشا» الذي يُطلق عليه «اتفاق السلام الشامل», وهو الذي وضع حدّاً لسنوات طويلة من الصراع والحرب الأهلية في جنوب السودان, وتشير بعض التقديرات إلى أن نحو مليوني شخص قد لقوا حتفهم جراء ما ترتّب على هذا الصراع من عنف وفاقة ومرض.
ويمثّل هذا الاتفاق تتويجاً ناجحاً لعملية سلام ماشاكوس التي انطلقت في يوليو عام 2002م, وعلى الرغم من شمولية هذا الاتفاق وخطورة ما انطوى عليه من بنود، ولا سيما إعطاء الجنوب حق تقرير المصير من خلال استفتاء عام 2011م؛ فإن عملية تطبيقه على أرض الواقع اعترضتها الكثير من العقبات والتحديات.
ويبدو من خلال الأحداث العاصفة التي مرّت بها السودان، منذ توقيع «اتفاق نيفاشا»، أن الأطراف الفاعلة في الداخل تفتقد الإرادة السياسية؛ في حين أن قوى الخارج ما فتئت تحاول قدر ما تستطيع أن تحقق أجندتها ومصالحها الخاصة من خلال ممارسة ضغوط غير مسبوقة على السودان.
ويُلاحظ أن ثمة مجموعة من العوامل الموضوعية التي أثّرت، ولا تزال، في مسيرة السودان في تلك المرحلة الانتقالية، والتي بات من خلالها أقرب ما يكون إلى ساعة الحسم, فالسودان يقع في محيط إقليم صراعي مركب من الناحية الجيوسياسية, فالأدوار الإقليمية تتشابك من حيث دعم حكومات الإقليم وتأييدها لحركات التمرد والعصيان في الدول الأخرى.
وعلى سبيل المثال؛ فإن الصراع المسلح الذي يشهده شمال أوغندا بين الحكومة الأوغندية وقوات جيش الرب للمقاومة؛ يلقي بتأثيراته السلبية على الصراع في جنوب السودان، وهو ما يجعل جيش الرب الأوغندي أحد العوامل المهمة التي تؤخذ بعين الاعتبار عند الحديث عن المنظومة الأمنية المستقبلية في جنوب السودان.
أضف إلى ذلك أن السودان نفسه يشهد مواقف صراعية موازية لا تقل خطورة عن الجنوب, فثمة صراع في الشرق وآخر في الغرب، كما توجد بؤر للتوتر قابلة للانفجار في الشمال, ولا شك أن تلك البؤر الصراعية المحتملة والمتفجرة تؤثر بلا أدنى شك في مستقبل العملية السلمية في الجنوب, ولعل الجميع هنا يطرح المطالب نفسها المنادية بقسمة الثروة والسلطة على أسس من العدالة والمساواة بين الجميع.
وثمة من يرى أن رحيل جون قرنق، الذي توفي في حادثة تحطم مروحية في 30 يوليو 2005م، يمثّل بحدّ ذاته عاملاً سلبيّاً له انعكاساته على مستقبل الجنوب, فالرجل كانت له رؤية وحدوية؛ حيث إنه حمل السلاح من أجل سودان موحّد ينطوي على نظامين مختلفين. أما سلفاكير الذي خلفه في قيادة الحركة، وتولّى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية؛ فيبدو أقل التزاماً بمبدأ السودان الواحد، وأكثر ميلاً للقبول بانفصال الجنوب.
وتحاول هذه الدراسة طرح ثلاثة تساؤلات مهمة:
– يرتبط أولها: بطبيعة اتفاق السلام الشامل والعوامل المؤثرة في تنفيذه.
– وثانيها: يدور حول الرؤية المستقبلية للمشهد السوداني في أعقاب استفتاء عام 2011م.
– أما الثالث: فيرتبط بموقع السودان في إطار عمليات الفك والتركيب الاستراتيجي التي تتعرض لها الأمة الإسلامية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
ويبدو أن بعض التحولات الفارقة التي شهدها السودان في العام الماضي 2009م قد تفتح باباً للأمل والتفاؤل بشأن مستقبل الوطن السوداني الجامع؛ إذ يمكن النظر إلى قرار التحكيم الدولي حول «أبيي» والذي جاء في جوهره توافقيّاً، بأنه يدفع باتجاه تحقيق السلام والتعايش المشترك.
وإذا كان السودان بموروثاته الثقافية والحضارية يختزل في مكوناته الاجتماعية والمادية ملامح عوالم ثلاثة تجمع بين العروبة والإفريقية والإسلام؛ فإن «منطقة أبيي» تمثّل بالنسبة للوطن السوداني الخيط الناظم لنسيج الأمة السودانية الواحدة, وقد أكّد هذا المعنى «دنيق ماجوك» الزعيم التاريخي للدينكا انقوك بقوله: «إن الرباط الذي يصل شمال السودان بجنوبه يمر عبر أبيي».
ولا يخفى أن فهم هذه التحولات والتطورات الإيجابية والسلبية التي شهدها الواقع السوداني الراهن، وإمكانيات التغير الناجمة عنها, يعد أمراً ضروريّاً لصياغة رؤية استراتيجية ترسم معالم الدولة السودانية في المستقبل المنظور.
أهداف الدراسة:
قد يبدو المشهد السوداني للوهلة الأولى بالغ القتامة والتشاؤم, فالحرب في دارفور لا يزال لهيبها مشتعلاً، وهو ما يؤثر في معيشة ملايين الأفراد وطرق حياتهم.
كما أن اتفاق السلام الشامل الذي أنهى الحرب الأهلية في الجنوب ما فتئ يصارع من أجل البقاء، ولا تزال بؤر التوتر وخطوط التماس الملتهبة بين الشمال والجنوب تهدّد بعودة العنف والصراع على نطاق واسع، وهو ما قد يفضي إلى تفتيت أركان الدولة السودانية وتفكيكها.
ومع ذلك؛ فإن واقع الأمور على الأرض قد شهد تحولات وتغيرات مهمة, تفسح المجال واسعاً أمام تحقيق فرص إيجابية فيما يتعلق بمستقبل الدولة والمجتمع في السودان.
ولعل الأمر هنا يتوقف على إرادة الأطراف الفاعلة الرئيسة في الداخل، ومواقف المجتمع الدولي من أجل تحويل هذه الفرص إلى إمكانيات حقيقية.
وعليه؛ فإن هذه الدراسة تسعى إلى تحقيق هدفين متلازمين:
أولهما: تقديم رؤية تحليلية شاملة لمختلف أبعاد عملية سلام الجنوب؛ بحيث تتناول تعقيدات الخبرة التفاوضية وسياقاتها المختلفة, فضلاً عن نتائجها وتحدياتها، وما تؤول إليه الأمور والأحوال في عام 2011م.
ثانيهما: الاستفادة من الخبرة السودانية في فهم استراتيجيات التعامل الدولي مع مناطق الأطراف وبؤر التوتر القلقة في العالم الإسلامي, فالخبرة الدولية في التعامل تشير إلى طرح جملة من المبادرات الإقليمية والدولية التي تستهدف تفتيت، أو إن شئت الدقة فقل إعادة صوغ العالم الإسلامي من الناحية الجيوسياسية.
منهج الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تبني مقولات وأدوات التحليل الاستراتيجي؛ حيث يتم وضع مسألة اتفاق السلام الشامل في إطار سياقها المحلي والإقليمي والدولي، ومحاولة تفهم العوامل المختلفة التي تؤثر في تنفيذها. كما أن مسألة التنبؤ تعد أساسية بالنسبة لأي رؤية استراتيجية.
ويبدو أن الإجابة عن سؤال ما هو مستقبل جنوب السودان بعد استفتاء حق تقرير المصير يطرح احتمالين: إما إقرار الوحدة، أو القبول بانفصال الجنوب, بيد أن ذلك لا يمنع من وجود احتمالات أخرى إذا أخذنا بمتغير العنف والحرب الأهلية في معادلة المستقبل.
ويوفر هذا النمط من التحليل القدرة على استنباط الأحكام واستخلاصها، وتطبيقها على المواقف نفسها والبؤر الصراعية التي يموج بها العالم الإسلامي, فمن الملاحظ أن عملية تشكيل التحالفات الدولية والإقليمية في مناطق العالم الإسلامي تعكس في أحد جوانبها طبيعة التنافس الدولي، ومحاولة إعادة صوغ هذه المناطق فكّاً وتركيباً بما يؤثر في نظم الأمن والاستقرار فيها.
وتعتمد عملية استشراف معالم المستقبل, والحديث عن مستقبل الخريطة الجيواستراتيجية للعالم الإسلامي, على جملة من العوامل المؤثرة في بيئة الصراعات التي يموج بها.
نذكر منها إلى جانب المتغيرات الداخلية والإقليمية أمرين:
– ديناميات التدخل الدولي: والذي يتجمّل تحت شعار محاربة الإرهاب تارة، والدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية تارة أخرى, ولا شك أن هذا التدخل يضفي مزيداً من التعقيد والتشابك على مجمل الصراعات التي تشهدها الدول الإسلامية.
– تأثيرات الثروات الطبيعية والمعدنية الضخمة: في معظم مناطق العالم الإسلامي، وهو ما يعني إضافة بُعْد جديد لطبيعة التوترات القائمة.
وإذا كانت هذه الثروات تؤدي إلى إعادة حسابات أطراف الصراع الداخلية؛ فإنها تجذب أطرافاً خارجية طامحة لكسب السيطرة والحصول على هذه الثروات، ويمكن أن نشير إلى أن أحد أهداف القيادة العسكرية الإفريقية «الأفريكوم», كما حدّدتها الإدارة الأمريكية, تتمثّل في محاربة النفوذ الصيني المتنامي في المنطقة، وتأمين الوصول إلى منابع النفط.
خطة الدراسة:
لتحقيق الأهداف السابقة، وللإجابة عن التساؤلات البحثية؛ تنقسم هذه الدراسة بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة إلى ثلاثة فصول؛ هي:
الفصل الأول: ويطرح قراءة تحليلية واعية لاتفاق السلام الشامل من خلال بيان الخبرة التفاوضية، ومصالح أطراف الصراع الأساسية من ناحية أولى، ومحاولة استكشاف أهم العوامل المؤثرة في تنفيذ الاتفاق من ناحية ثانية، ومناقشة خبرة الحكم الذاتي ومسيرته في أثناء الفترة الانتقالية, وتداعيات ذلك على المشهد السوداني من ناحية ثالثة.
أما الفصل الثاني: ويأتي تحت عنوان «استفتاء حق تقرير المصير.. خيار الوحدة وتحدّي الانفصال»؛ فإنه يناقش إشكالية الاستفتاء، وتصارع الإرادات والمصالح, كما أنه يرسم صورة استشرافية لوضع السودان في مرحلة ما بعد استفتاء الجنوب، وما الآليات والسبل اللازمة لاحتواء انفراط العقد الناظم لوحدة السودان وتكامله الوطني.
ويطرح الفصل الثالث والأخير: أبرز استراتيجيات «التفتيت» في العالم الإسلامي؛ من خلال بيان أهم مبادئ مخطط تفتيت وتقسيم الأمة الإسلامية وأدواته، وتطبيقات ذلك في الواقـعين الإفريقي والآسيوي.
الخاتمة:
وعليه؛ فإن الدراسة ترى أن المدخل الصحيح لحل المسألة السودانية بشكل عام يتمثّل في معالجة قضايا التهميش والإقصاء، وإعادة النظر في مشروع الدولة الوطنية الحديثة؛ بحيث يُعلي من قيم العدالة والمساواة كأساس للمواطنة والهوية المشتركة.
وأحسب أن هذا المدخل يمثّل حلاً لمسألة الجنوب نفسه الذي يعاني هو الآخر الانقسام والإقصاء لبعض مكوناته الأساسية.
وعلى سبيل المثال؛ فإن النخبة الحاكمة في الجنوب، وتمثلها الحركة الشعبية لتحرير السودان, تواجه الموقف نفسه؛ حيث تتصارع الهويات والانتماءات الداخلية بين الجنوبيين, يقول في ذلك أحد الكتاب: «على الرغم من السنوات الطويلة من القتال المشترك بهدف بناء الدولة؛ فإن معظم المثقفين اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، لا يزالون ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم دينكا أو نوير أو مورو أو شلك أو زاندي قبل كونهم جنوبيين»!
ونظراً لأن المدخل الشمولي لمعالجة حالة الخلل الهيكلية التي عاناها المجتمع السوداني يحتاج إلى فترة زمنية طويلة؛ فإن النخبة الجنوبية قد تعتمد في تحديد خياراتها الاستراتيجية الراهنة على قراءة واقع توازنات القوى الدولية التي تدفع باتجاه تصادم الثقافات والحضارات، وهو ما يعني أن إعلان دولة جنوبية مستقلة قد يكون أمراً مقبولاً بالنسبة للقوى الدولية الضاغطة، وخصوصاً أن مثل هذه الدولة تسيطر عليها نخبة مسيحية ذات توجهات إفريقية؛ بما يؤدي إلى تقويض المشروع الحضاري الإسلامي الذي يرفعه المؤتمر الوطني الحاكم في السودان.
ولذلك نرى أن حالة انفصال جنوب السودان واستقلاله أو بقائه في ظل كونفيدرالية هشّة؛ يؤكّد أن مخطط تفتيت العالم العربي والإسلامي وتجزئته يجري على قدم وساق، وأن مستقبل المنطقة، لو تُركت الأمور على ما هي عليه، يُنذر بكارثة لا تُحمد عقباها!
ولعل قراءة الوضع الراهن تفيد أن بعض أجزاء الدائرة الإسلامية أضحت مسرحاً للنفوذ الأمريكي، وبتعاون كامل مع الهيمنة الإسرائيلية، أما باقي المناطق فإنها سوف تخضع لمفهوم التفتيت والتجزئة الطائفية والعرقية.
إن ذلك كله يقتضي من الجميع التدبر والتبصر فيما آلت إليه الأمور والأحوال؛ بحيث يصبح المخرج والملاذ هو إعادة تفعيل الرابطة الدينية التي تجمع في إطارها العرب والأفارقة والأكراد، والأتراك والفرس وغيرهم, وذلك بغية التصدي لمشروع الهيمنة والتفتيت الذي يواجه العالم الإسلامي.