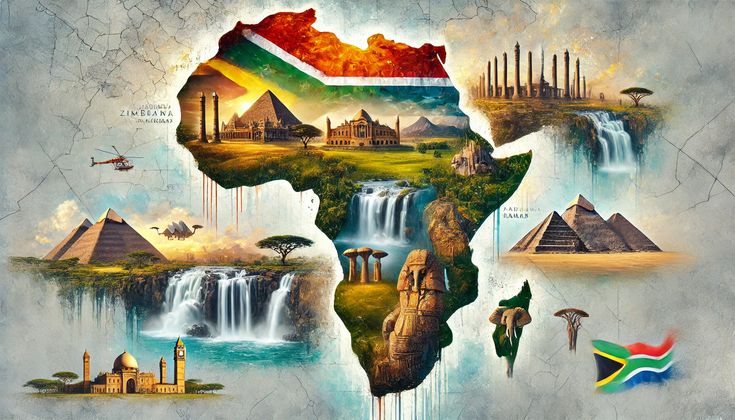د. نِهاد محمود
باحثة متخصصة في الشؤون الإفريقية
دكتوراه في العلوم السياسيّة، كلية الدراسات الإفريقية العليا- جامعة القاهرة
تمهيد:
 تُواجه العديد من الدول الإفريقية اليوم تحديات متسارعة ومُعقَّدة تمتدّ إلى مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتصل في بعض الحالات إلى مستوى الهشاشة. وتبرز في هذا السياق الحاجة إلى دراسات معمّقة تسعى إلى فهم السياقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية التي تشكَّلت في ظلها هذه الدول، سواء خلال الحقبة الاستعمارية أو في مرحلة ما بعد الاستقلال، بما يساعد على تفسير طبيعة الأوضاع الراهنة في القارة وكيفية تجاوزها.
تُواجه العديد من الدول الإفريقية اليوم تحديات متسارعة ومُعقَّدة تمتدّ إلى مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتصل في بعض الحالات إلى مستوى الهشاشة. وتبرز في هذا السياق الحاجة إلى دراسات معمّقة تسعى إلى فهم السياقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية التي تشكَّلت في ظلها هذه الدول، سواء خلال الحقبة الاستعمارية أو في مرحلة ما بعد الاستقلال، بما يساعد على تفسير طبيعة الأوضاع الراهنة في القارة وكيفية تجاوزها.
وفي هذا الإطار، يأتي حديثنا حول كتاب “السياسة الإفريقية من الداخل” للمؤلفين الأكاديميين: كيفن سي. دن وبيير إنجلبيرت؛ بوصفه مساهمة نوعية في تحليل تجربة الدولة الإفريقية وإعادة إدماجها ضمن النقاشات الأكاديمية المعاصرة حول طبيعة التحديات المُركَّبة التي تواجهها القارة اليوم، سواء في مجالات التنمية، العدالة الاجتماعية، أو تحسين نوعية الحياة.
أولاً: كتاب “السياسة الإفريقيّة من الداخل”… بنيته وأهميته
يتكون كتاب “السياسة الإفريقية من الداخل” من ثمانية فصول، محاولًا تقديم رؤية تحليلية شاملة لبنية الدولة والمجتمع والسياسة في القارة. يبدأ الفصل الأول بتوضيح أهمية دراسة السياسة الإفريقية، مبرزًا كيف تمثل تحوُّلات القارة عنصرًا مؤثرًا في النظام الدولي وفي قضايا التنمية والأمن والهجرة. أما الفصل الثاني فيتناول تطور الدولة الإفريقية منذ المرحلة الاستعمارية حتى ما بعد الاستقلال، موضحًا مسارات بناء الدولة ومظاهر هشاشتها في بعض السياقات.
ويُركّز الفصل الثالث على المواطنين “الأفارقة” والهوية والسياسة، متناولًا أثر العِرْق والانتماء والدين في تشكيل السلوك السياسي وبناء الشرعية. ويعرض الفصل الرابع ممارسات السلطة وآلياتها، محللًا طبيعة الحكم وأدوات السيطرة والإدارة في النظم الإفريقية. ثم يتناول الفصل الخامس طيف الأنظمة السياسية الممتد بين الديمقراطية والسلطوية، مع مناقشة تجارب التحول السياسي وتحديات ترسيخ الحكم الرشيد.
أما الفصل السادس فيتطرق إلى علاقة الاقتصاد بالسلطة وقضايا التنمية والاعتماد على الخارج ومساعداته، فيما يركز الفصل السابع على المسائل المتعلقة بالحرب والصراع والأمن داخل القارة، من خلال مناقشة أسبابها وتأثيراتها الإقليمية. ويختتم الكتاب بالفصل الثامن الذي يشتبك مع العلاقات الدولية للدول الإفريقية، مبرزًا موقع القارة في التفاعلات العالمية وتحالفاتها القديمة والجديدة مع القوى الكبرى.
ثانيًا: قراءة في أهم المضامين والقضايا
يُقدِّم كتاب “السياسة الإفريقيّة من الداخل” -في طبعته الثانية الصادرة عام 2019م- قراءة تحليليّة لبنية الدولة والمجتمع والسياسة داخل القارة الإفريقية؛ من خلال تتبُّع المراحل التاريخية والتحوّلات الكبرى التي مرت بها منذ ما قبل الاستعمار وحتى الوقت الراهن. ومن هذا المنطلق، نتناول أبرز هذه القضايا على النحو التالي:
1-إفريقيا والتصوّرات المسبقة:
يناقش هذا الفصل من كتاب “السياسة الإفريقية من الداخل” فكرة تجاهل إفريقيا في الوعي والسياسات الغربية، مرجعًا ذلك إلى تراكمات تاريخية جعلت القارة تُصوَّر من خلال قوالب نمطية سلبية عن الفقر والفساد والصراع. ويوضّح أن هذا يؤثر في السياسات الخارجية تجاه إفريقيا؛ إذ كثيرًا ما تُبنَى القرارات الدولية على افتراضات سطحية لا تستند إلى فهم عميق للواقع السياسي والاجتماعي الإفريقي.
وفي هذا السياق، يؤكّد المؤلفان أن دراسة السياسة الإفريقية ليست ضرورة أخلاقية أو معرفية فحسب، بل إنها مدخل لفهم التفاعلات العالمية المعاصرة؛ حيث إن أزمات القارة وفرصها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمصالح الأمن والاقتصاد والهجرة والطاقة في مناطق أخرى من العالم.
في المقابل، يدعو الكتاب للنظر إلى إفريقيا ليس فقط كميدان للأزمات، بل ككيان غني بالدروس النظرية والتطبيقية في علم السياسة المقارنة؛ حيث تمثل تجارب دولها مختبرًا لفهم قضايا الشرعية السياسية، وبناء الدولة، والهوية، والتنمية، فالتحولات الديمقراطية في بنين، والتجارب الأمنية في نيجيريا والكونغو، ومسارات العدالة في رواندا، كلّها تُقدّم رؤى مُعمَّقة تعيد صياغة كثير من النظريات السياسية الكلاسيكية. وبهذا المعنى، فإن دراسة السياسة الإفريقية لا تسهم فقط في تحسين نَهْج تعامل العالم مع القارة، بل تُثري أيضًا عِلْم السياسة نفسه.
2-الدولة… من الكيانات التقليدية إلى نماذج ما بعد الاستقلال الحديثة
في هذا السياق، يشير الكتاب إلى تطوُّر مفهوم الدولة داخل إفريقيا منذ العصور السابقة للاستعمار الأوروبي؛ حيث تنوعت الكيانات السياسية بين مجتمعات لامركزية تعتمد على النَّسب والقرابة وأخرى مركزية تمثلت في الممالك والإمبراطوريات الكبرى مثل غانا ومالي وأشانتي وسوكوتو؛ حيث كانت السلطة تُمارس على الأشخاص لا على الأرض، وتستمد شرعيتها من الروابط الروحية ودرجات القرابة والنسب. ومع التدافع الأوروبي على القارة في أواخر القرن التاسع عشر، فُرِضَ النظام الاستعماري بالقوة، ورُسِمَتْ حدود مصطنعة أقامت كيانات جديدة خاضعة للسيطرة الأوروبية.
وفي هذا الإطار اتسم الحكم الاستعماري بطابعه الاستغلالي القائم على الجباية والعمل القسري، وأدخل اقتصاديات إنتاج موجهة للتصدير على حساب الاكتفاء المحلي. كما تباينت أساليبه بين “الحكم غير المباشر” البريطاني الذي اعتمد على الزعامات التقليدية، و”الحكم المباشر” الفرنسي الذي سعى إلى الدمج الإداري والثقافي، مما خلَّف إرثًا قانونيًّا واجتماعيًّا مزدوجًا.
ومع انقضاء الحقبة الاستعمارية، انتقلت إفريقيا من مرحلة السيطرة الأجنبية إلى مرحلة بناء الدولة الوطنية الحديثة، غير أن هذا الانتقال لم يكن قطيعة حقيقية مع الماضي الاستعماري، بل امتدادًا له في كثير من الجوانب، فقد ورثت الدول المستقلة حدودًا مصطنعة ونُظمًا بيروقراطية ضعيفة واقتصادات تابعة، ما جعل الاستقلال السياسي أقرب إلى استمرار وجه الاستعمار، لكن بأنماط أكثر حداثة وتنوعًا. وهكذا جاءت الدولة ما بعد الاستعمار مُحمَّلة بتناقضات التاريخ، تجمع بين إرث الكيانات التقليدية السابقة على الاستعمار ونُظُم الدولة التي فرضها المستعمر، وهو ما أفرَز لاحقًا أزمات مزمنة في الهوية الوطنية، وضعفًا في مؤسسات الحكم، واستمرارًا للتنازع حول الشرعية والسلطة في التجربة الإفريقية الحديثة.
3-تحوّلات النظم السياسية… من الاستقلال إلى ما بعد الحرب الباردة
استكمالًا لما أوردناه مسبقًا، شهدت الدول الإفريقية منذ الاستقلال مسارًا متقلبًا في تجاربها السياسية؛ إذ ورثت معظمها دساتير ديمقراطية شكلية من القوى الاستعمارية من دون ترسيخ فِعْلي للممارسات الديمقراطية، فسرعان ما انهارت تلك التجارب أمام تغلغل الحكم الشخصي وتوسع الزبائنية السياسية.
في هذا الوقت، تحولت الدولة إلى أداة لتوزيع الموارد واستمالة الولاءات، فضعفت المؤسسات الرسمية وتلاشت الرقابة في الكثير من دول القارة الإفريقية، ما مهَّد لهيمنة الحزب الواحد والانقلابات العسكرية، وتبرير الاستبداد بدعوى الحفاظ على الوحدة الوطنية أو الخصوصية الإفريقية. كما ارتبط هذا التراجع بعوامل بنيوية كضعف الطبقة الوسطى، واعتماد الاقتصاد على المواد الأولية، ودعم القوى الخارجية للأنظمة السلطوية خلال الحرب الباردة، ما جعل الاستقرار مقدَّمًا على القضايا السياسية الأخرى كتبنّي قِيَم الديمقراطية وغيرها.
ومع نهاية الحرب الباردة ظهرت موجة من التحول صوب الديمقراطية في أنحاء القارة؛ إذ دفعت الضغوط الداخلية والأوضاع الدولية الجديدة كثيرًا من الدول إلى تبنّي التعددية والانتخابات التنافسية، بدرجات تفاوتت بين إصلاحات جوهرية وأخرى شكلية. لكن سرعان ما تبين أن معظم المكاسب الديمقراطية كانت ظرفية؛ إذ تراجعت في العقود التالية مع بروز ما يسمى بالنظم الهجينة التي تمزج بين المظاهر الديمقراطية وآليات التحكم السلطوي، فرغم حضور بعض أشكال الديمقراطية في قلة من الدول مثل غانا وبنين والرأس الأخضر، فإن الغالبية ظلت تحت سلطة أنظمة شبه ديمقراطية تحتكر النفوذ وتتحكم في مسار الانتخابات، مستندة إلى شبكات الزبائنية نفسها التي كانت سائدة قبل التحوُّل.
وهكذا ظلّ المسار السياسي الإفريقي محكومًا بعلاقة مُعقَّدة بين إرث الحكم الشخصي القديم ومحاولات التحديث السياسي؛ حيث لم يُؤدِّ التحول الديمقراطي إلى قطيعة مع الماضي بقَدْر ما أعاد إنتاجه في صِيَغ وقوالب جديدة.
4-مسارات الصراعات… من الحروب الأهلية إلى الفاعلين من دون الدولة:
يُقدّم المؤلفان في هذا الفصل تحليلًا معمقًا لجذور وأنماط الصراعات في القارة الإفريقية منذ الاستقلال، موضحَين أن معظم الدول واجهت شكلًا من أشكال الحرب أو العنف السياسي الذي عطَّل التنمية وأضعف مؤسسات الدولة. ويبيّنان أن أكثر من 70 حربًا اندلعت في إفريقيا منذ الثمانينيات، وأن متوسط مدة الصراع فيها يبلغ نحو 22 عامًا، وهو أعلى من المتوسط العالمي بـ7 سنوات، ما يعكس الطابع المزمن للعنف في القارة.
ومع ذلك، يؤكد المؤلفان أن إفريقيا ليست فضاءً واحدًا للفوضى؛ فهناك دول مستقرة نسبيًّا مثل بوتسوانا وغانا، وأخرى استطاعت التعافي من صراعاتها مثل أنجولا ورواندا.
وفي هذا السياق، يعرض الكتاب تصنيفًا لأنماط الصراعات التي شهدتها القارة الإفريقية، والتي شملت حروب التحرير الوطني ضد الاستعمار كما في كينيا وأنجولا وموزمبيق، والحروب بين الدول مثل الحرب الإثيوبية–الإريترية (1998– 2000م)، والحروب الانفصالية “حرب بيافرا” (1967 –1970م)، والصراع في جنوب السودان، إضافةً إلى حروب التمرد الداخلي التي سعت إلى السيطرة على الحكم والثروات كما في ليبيريا وسيراليون.
ويُبرز المؤلفان هنا أن نهاية الحرب الباردة كانت نقطة تحوُّل في طبيعة الصراعات؛ إذ تراجعت الدوافع الأيديولوجية لصالح النزاعات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وبرزت أنماط جديدة من الحروب الأهلية متعددة الأطراف.
وفي مرحلة لاحقة، يشير الكتاب إلى بروز جماعات إرهابية تبنَّت العنف المسلح كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية أو عقائدية، ما أضاف بُعدًا جديدًا إلى مشهد الصراع في القارة، فقد استغلت هذه الجماعات هشاشة الدول، وضعف مؤسساتها، واتساع رقعة الفقر والتهميش لتجنيد الأتباع وتوسيع نطاق نفوذها، خصوصًا في مناطق الساحل، القرن الإفريقي، شمال نيجيريا.
كما يوضّح أن هذه التنظيمات اعتمدت على شبكات التمويل غير المشروعة، وتجارة السلاح والموارد الطبيعية، وعلى ربط نفسها بخطابات عالمية تمنحها زخمًا سياسيًّا ودعائيًّا رغم أن دوافعها في الغالب محلية، ما جعل الصراعات في إفريقيا أكثر تعقيدًا؛ حيث لم تَعُد المواجهة بين جيوش نظامية أو فصائل متمردة فحسب، بل أصبحت تشمل فواعل من دون الدولة تتحدَّى مفهوم الدولة ذاته، وهو ما يستلزم معالجة الجذور العميقة للصراعات عبر تنمية اقتصادية شاملة، وإصلاح سياسي ومؤسسي، وتعزيز آليات السلام الإقليمي -عبر التكتلات الإقليمية مثل إيكواس وإيجاد وغيرهما-، لمواجهة التحديات الإرهابية والأمنية في آنٍ واحدٍ.
5-الاقتصاد الإفريقي من الداخل… بين الأعباء التاريخية والاختلالات البنيوية:
يُوضّح الكتاب هنا أن الاقتصاد الإفريقي تحمّل عبر تاريخه سلسلة متشابكة من الأعباء التاريخية والبيئية والسياسية التي جعلت التنمية فيه معقدة وشديدة الصعوبة، فالدول الإفريقية خرجت من الحقبة الاستعمارية مثقلة بإرث من الاختلالات البنيوية، كاقتصادات موجَّهة نحو الخارج، واعتماد شبه كامل على تصدير المواد الخام، وتفتت اجتماعي وإثني بفعل تجارة الرقيق التي ساهمت في تقليل التماسك بين المجتمعات المحلية.
كما يستكمل المؤلفان أن الطبيعة ذاتها لم تكن رحيمة؛ إذ شكَّل المناخ الاستوائي القاسي، والأمراض المتوطنة، والجفاف والتصحر، عوائق أمام الزراعة المستقرة والتنمية الصناعية. وإلى جانب ذلك، عانت القارة مما عُرِفَ بـ«لعنة الموارد»؛ حيث تحوَّلت الثروات الطبيعية –من النفط إلى الذهب والماس– إلى مصدر للفساد والصراعات، في ظل مؤسسات ضعيفة وحكومات غير خاضعة للمساءلة. وتظهر حالات مثل تشاد ونيجيريا كيف فشلت عوائد الموارد في إحداث التنمية، بينما تسبّبت في ترسيخ أنماط الحكم الزبائني والاعتماد على الريع بدلًا من الإنتاج.
كما يستفيض الكتاب في تحليل العبء الصحي وتأثيره التنموي، موضحًا كيف أضعفت الأمراض الاستوائية الكبرى -مثل الملاريا والإيدز والإيبولا- الإنتاجية، وأرهقت البنية الصحية الهشّة بالفعل، وأسهمت في إبطاء التنمية وتفاقم الفقر. ومع ذلك، فإن أخطر العوامل ليست فقط خارجية أو طبيعية، بل أيضًا نتاج السياسات الإفريقية نفسها؛ إذ إن الحقبة التي تلت الاستقلال تميَّزت بتجارب اقتصادية اعتمدت على تدخل الدولة والاحتكار والتأميم، ما أدّى إلى خلق أجهزة بيروقراطية متضخمة وفاسدة. وبمرور الزمن، هيمنت شبكات الزبائنية على الموارد العامة، وتحوَّلت الدولة إلى وسيلة لتوزيع المنافع لا لتحقيق التنمية. ويشير الكتاب في هذا الإطار أن هذه السياسات، مع ضعف المؤسسات، قادت إلى انكماش اقتصادي طويل بين منتصف السبعينيات والتسعينيات، قبل أن تعود القارة إلى النمو بفضل ارتفاع أسعار السلع المصدَّرة والمساعدات الدولية. ومع ذلك، يبقى الاقتصاد الإفريقي أسير الاعتماد على الخارج، سواء في التمويل أو في تشكيل السياسات، وهو ما يجعل مسار التنمية في القارة هشًّا ومتذبذبًا رغم فترات التحسن النسبي.
6-الهويّة كمدخل لفَهم السياسة والمجتمع الإفريقي:
يقدم الكتاب في هذا القسم رؤية مفادها أن فهم السياسة الإفريقية يستلزم الانطلاق من المجتمع ذاته؛ إذ لا توجد الدولة بمعزل عن الناس، وأن قراءة الحراك السياسي في القارة يستوجب دراسة أنماط التعبئة والعمل الجماعي داخل المجتمعات الإفريقية.
ومن هنا يركّز على أن مفاهيم مثل الطبقة والنوع الاجتماعي والمجتمع المدني تُعدّ ضرورية لفهم الحياة السياسية، لكنها تأخذ أشكالًا مختلفة في السياق الإفريقي. كما أن البنية الإثنية تُعدّ من أبرز السمات التي تُشكِّل السلوك السياسي للأفراد والجماعات. ومن هنا يرى المؤلفان أن فَهْم السياسة الإفريقية لا يكتمل دون دراسة متعمقة لمفاهيم الهوية الإثنية، والولاءات الجماعية، وأدوارها في تكوين الولاء الوطني أو تهديده.
كما ينبّه أن مسألة الإثنية يمكن تناولها بثلاث زوايا رئيسية؛ الأولى تنظر إليها كهوية ثابتة ومتجذرة (المدخل الأوّلي)، والثانية ترى أنها نتاج عمليات تاريخية واجتماعية (المدخل البنائي)، والثالثة تعتبرها أداة تُستخدم لتحقيق مصالح سياسية (المدخل النفعي). ويؤكد أن هذه المقاربات ليست متعارضة بقدر ما هي أدوات تحليلية متكاملة تُفسّر تنوع التجارب الإفريقية في التعامل مع التعدد الإثني. ويرى المؤلفان استنادًا لذلك، أن منظور فهم الإثنية ينعكس مباشرة على طبيعة السياسات العامة وآليات الحكم وبناء الدولة، كما يظهر في تجارب مثل نيجيريا، رواندا، وتنزانيا، التي تبنَّت سياسات مختلفة تراوحت بين القمع، والدمج، والاستيعاب المؤسسي للهويات الإثنية ضمن النظام السياسي.
خاتمة:
من خلال قراءة كتاب “السياسة الإفريقية من الداخل”؛ يتبيّن أنه عمل أكاديمي ثريّ يسعى إلى تقديم فَهْم أكثر شمولًا لبنية الدولة الإفريقية، وممارسات السلطة، ومناطق التقاطع بين الهوية والمجتمع والاقتصاد والسياسة.
في المقابل، يُؤخَذ على الكتاب تركيزه على المقاربة الغربية في التحليل السياسي؛ إذ ينطلق من مفاهيم ونماذج نظرية غربية مثل التحوُّل الديمقراطي والحكم الرشيد والنوع الاجتماعي، وهي أدوات تُسهم في التحليل لكنّها تظل مُقيَّدة بإطار فكري لا ينبع كليًّا من التجربة الإفريقية.
لكن ذلك، يظل إسهامًا معرفيًّا مهمًّا في دراسة السياسة الإفريقية؛ من خلال تحليل تطوُّر الدولة وبِنَى السلطة في سياقات ما بعد الاستعمار، مبيّنًا كيف تتفاعل العوامل المحلية مع الدولية في تشكيل أنماط الحكم والتحوّل السياسي داخل القارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الكتاب:
Kevin C. Dunn and Pierre Englebert, Inside African Politics, (Boulder: Lynne Rienner Publishers, Second Edition, 2019).