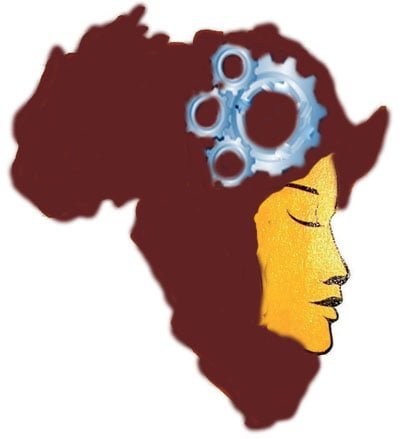شهدت قارة إفريقيا، في خلال العقدين الماضيين من الزمان، سلسلة من التغيّرات السياسية والفكرية، ودعوات لمزيد احترام لحقوق الأفراد والشعوب وحرياتهم؛ أثمرت بعض آثارها على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية في صورة مبادرات اتحادية وتكاملية.
وفي المقابل؛ أسفرت – ولأول مرة – عن الخروج عن مبدأ الحفاظ على الحدود الموروثة عن الاستعمار، وذلك بإقرار انفصال جنوب السودان عن شماله وقيام دولة جنوب السودان، الأمر الذي يشير من جانب إلى التعارض الذي طالما تحدّث عنه بعض المحللين بين مبدأ الحفاظ عن الحدود الموروثة ومبادئ حقوق الإنسان وحق تقرير المصير، ويرسّخ ازدواجية المعايير الدولية في تطبيق تلك المبادئ وإقرار ذلك الحق؛ بما يتوافق – في غالب الأحوال – ومصالح القوى الكبرى ورؤيتها.
ومع اندلاع ما اُصطلح على تسميته إعلامياً: «ثورات الربيع العربي» في الشمال الإفريقي، والإطاحة بنُظُم حكم ظُنّ طويلاً أنها محصّنة بفعل علاقاتها الإقليمية والدولية، بدا أن هناك مناخاً جديداً يتشكّل في المنطقة، وبالرغم من اختلاف موقف الأفارقة (شعوباً، وحكاماً) في تقييم التطورات في الشمال الإفريقي؛ يرى بعض الناس أن القارة لا محالة سائرة في طريق الخلاص من ربقة المواريث الاستعمارية.
وإجمالاً؛ يمكن القول إن أول المشاريع الفكرية التي طُرحت على الساحة الإفريقية كانت فكرة الوحدة الإفريقية، وقد نشأت هذه الفكرة خارج القارة، بوصفها أداة لمواجهة الآخر في المهجر قبل أن تكون أداة لمواجهة المستعمر، والمطالبة بالاستقلال ووحدة القارة، وهي المطالب التي تكسّرت على نصال التمسك بسيادة الدولة من جانب معظم دول القارة بعد الاستقلال، منذ منتصف الخمسينيات ومطلع الستينيات من القرن العشرين؛ فمع ترسّخ واقع الدولة الوطنية بدأت مشروعات نهضة خاصة بكل قُطْر، اتفقت في معظمها في طابعها الاشتراكي والإنساني، كان من أبرزها فكرة الرئيس التنزاني جوليوسنيريري عن «الأوجاما».
ومع موجة التحولات الدولية والإقليمية منذ أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، في أعقاب تفكك الاتحاد السوفييتي، شهدت إفريقيا جدلاً فكرياً كبيراً حول ضرورات التحول الديمقراطي في القارة، تزامن مع تبنّي كثير من النّظم الإفريقية لآليات النّظم الديمقراطية، التي باتت الطابع الغالب لدول القارة في أقل من عقد من الزمان، ومع تلك التحولات عاود خطاب الوحدة الإفريقية البروز من جديد في صورة مشروع النهضة الإفريقية الذي دعا إليه الرئيس الجنوب إفريقي السابق «ثابوامبيكي»، والذي تبلور بعد ذلك واقعياً في مبادرة «النيباد»، التي تزامنت معها مبادرة التحول من «منظمة الوحدة الإفريقية» إلى «الاتحاد الإفريقي»، والتي تزعمها الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
ويسعى هذا المقال لإلقاء الضوء على أهم المبادرات الفكرية التي طُرحت على الساحة الإفريقية سعياً للتخلص من ربقة الاستعمار وتحقيق النهضة، ونصيب كلٍّ منها من النجاح، أو الإخفاق، وأسباب ذلك؛ وصولاً إلى استشراف مستقبل القارة في ضوء التغيّرات الجارية في القارة بفعل ثورات الشمال، وتحولات الجنوب.
ويتناول المقال المحاور الآتية:
– فكرة الوحدة الإفريقية، ومراحل تطورها.
– تجليات فكرة الوحدة الإفريقية ومآلاتها بعد الاستقلال.
– من الوحدة إلى الاتحاد والنهضة والحكم الرشيد.
– خاتمة: هل تحررت إفريقيا من فكر الاستعمار؟
أولاً: فكرة الوحدة الإفريقية، ومراحل تطورها (1):
تعد فكرة الوحدة الإفريقية أقدم الإسهامات الفكرية التي أدت دوراً محورياً على الساحة الإفريقية، بالرغم من نشأتها خارج القارة، وساهم في بلورتها كثير من المفكرين من غير الأفارقة، من الذين جمعهم بالأفارقة وحدة الآمال والآلام، وقد مرّت فكرة الوحدة الإفريقية بعدة مراحل، يمكن إجمالها في ثلاث مراحل على النحو الآتي:
أ – مرحلة وحدة اللون والقهر:
نشأت هذه المرحلة – كما سبقت الإشارة – خارج قارة إفريقيا، وتطورت وسط ما وصفه بعض المحللين بأنه «مثلث الأطلنطي للنفوذ»، والذي تتكون أضلاعه من العالم الجديد (الأمريكيتين) وأوروبا وإفريقيا؛ حيث تشرّب الأفارقة أفكار الوحدة في طورها الأول – الذي يمتد من منتصف القرن التاسع عشر إلى قبيل القرن العشرين – من أوضاعهم المزرية في العالم الغربي بصفة عامة، والولايات المتحدة الأمريكية بخاصة (2) .
وقد اتسمت تلك المرحلة بالعاطفية الناجمة عن شعور الأفارقة بفقدانهم أوطانهم، وما نجم عن ذلك من استعبادهم واضطهادهم عنصرياً واحتلالهم، فكانت التجليات الأدبية، وبخاصة الشعرية المؤكدة لتلك المعاني، والمطالبة باستعادة الكرامة والاعتزاز بالذات الإفريقية السوداء، وهي المطالبة التي وصلت ذروتها في أشعار «إيمي سيزار» وتيار «الزنوجة»، وكذا أعمال «ليوبولد سنجور»، وعكسها حركياً وتنظيمياً «ماركوس جارفي» أحد زنوج جامايكا الذي نادى بعنصرية سوداء في مواجهة العنصرية البيضاء، ودعا إلى عودة الزنوج إلى إفريقيا، وهي الدعوة التي عارضها «وليم دي بويس» أحد رواد حركة الوحدة الإفريقية، والذي دعا إلى أن يكافح الأفارقة في المهجر للحصول على حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها (3).
ب – مرحلة «مؤتمرات الجامعة الإفريقية» Pan –Africanism:
والتي بدأت منذ نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين مع أول مؤتمر عُقد تحت هذا الاسم في لندن استجابة لدعوة محام من جزر ترينداد، هو «سيلفسترويليامز» الذي كان أول من تحدث عن الجامعة الإفريقية، وانصبّ اهتمام المؤتمر في البحث عن سبل تحسين أوضاع الأفارقة السود والمطالبة بحسن معاملتهم، وتوالت مؤتمرات الجامعة حيث عُقد المؤتمر الثاني في باريس عام 1919م برئاسة «دي بويس»، والثالث في لندن وبروكسل عام 1921م، وعُقد المؤتمر الرابع في لندن ولشبونة عام 1923م، وكان المؤتمر الخامس للجامعة الإفريقية عام 1927م في نيويورك هو آخر مؤتمرات الجامعة الذي يُعقد برئاسة «وليم دي بويس».
ويُلاحظ، بصفة عامة، أن تلك المؤتمرات جميعها ركزت مطالبها في البحث عن سبل تحسين أوضاع الأفارقة، ولم تتجاوز في مطالبها السياسية المطالبة بإقامة حكم ذاتي محلي للجماعات الوطنية(4) .
وقد مثّل «مؤتمر الوحدة الإفريقية»، الذي عُقد في «مانشستر» ببريطانيا عام 1945م، نقلة كبيرة في طبيعة مؤتمرات الوحدة وأهدافها؛ حيث شهد المؤتمر لأول مرة مشاركة فاعلة من زعماء إفريقيا الشبان الذين اكتسبوا بسرعة شهرة وصيتاً ذائعاً في بلدانهم، وفي مقدمتهم «كوامي نكروما» من ساحل الذهب (الاسم القديم لغانا)، والذي أصبح بعد ذلك أول رئيس لها، والزعيم «س.ل. إكينتولا» (أصبح بعد ذلك رئيس وزراء نيجيريا)، و «جوموكيناتا» (أصبح رئيساً لكينيا عند استقلالها)، وممثل عن الدكتور ايزيكوي (أصبح رئيساً لنيجيريا بعد ذلك)، كما أن المؤتمر طالب بقوة ووضوح بالحكم الذاتي والاستقلال لإفريقيا السوداء (5).
وتجدر الإشارة إلى أنه من رحم «مؤتمر مانشستر» ولدت السكرتارية القومية لغرب إفريقيا، والتي نظمها الدكتور نكروما، وتعهدت تلك السكرتارية في مؤتمرها، الذي عقدته في أغسطس 1946م، بتطوير فكرة اتحاد فيدرالي من غرب إفريقيا، حتى يمكن استخدامه في النهاية في تكوين الولايات المتحدة الإفريقية، وهي المرة الأولى – قدر ما هو معروف لدينا – التي يُستخدم فيها اصطلاح «ولايات متحدة إفريقية»(6) .
ج – «الانتقال إلى إفريقيا»:
ويؤرخ لها بانعقاد «مؤتمر الوحدة الإفريقية المستقلة الأول» عام 1958م، في أكرا عاصمة غانا، حيث اجتمعت دول إفريقيا المستقلة آنذاك (باستثناء جنوب إفريقيا) في أكرا في أبريل عام 1958م، وكانت ثلاث منها تنتمي لإفريقيا السوداء (وهي: إثيوبيا، غانا، وليبيريا)، وخمس دول عربية إسلامية (هي: مصر، تونس، ليبيا، السودان، ومراكش)، وأكدت أعمال المؤتمر زيف الحواجز اللونية والعقدية واللغوية أو الجغرافية (الصحراء الكبرى) بين دول القارة (7)، وعند انتقالها إلى القارة اكتسبت الحركة ملامح وأهدافاً جديدة.
ويمكن إجمال أهم ملامحها فيما يأتي من شعارات وأهداف؛ رفعتها الحركة ونادت بها(8) :
1- إفريقيا للإفريقيين: بمعنى الاستقلال التام ونبذ الاستعمار في جميع صوره وأشكاله.
2- العمل على قيام ولايات متحدة إفريقية: ومثالها الأعلى قارة متحدة اتحاداً كلياً عن طريق سلسلة من الاتحادات الإقليمية التي تربط الأقطار بعضها ببعض.
3- التوفيق بين الأصالة والمعاصرة: من خلال استقصاء الشخصية الإفريقية، وإعادة تشكيل المجتمع الإفريقي؛ بأن يُؤخذ من ماضيه ما هو قيّم ومرغوب فيه، وربطه بالأفكار المدنية الحديثة.
4- بلورة قومية إفريقية: تحل محل النظام القبلي في الماضي.
5- النهوض بالاقتصاد القومي للدول الإفريقية: ليحل محل النّظم الاقتصادية الاستعمارية.
6- تضامن الشعوب السوداء في كل مكان، والتحالف الأخوي مع الشعوب الملونة: على أساس التاريخ المشترك في الكفاح ضد الاستعمار.
وتجدر الإشارة إلى أن انتقال فكرة الوحدة الإفريقية إلى قارة إفريقيا تزامن مع بروز تيار ثقافي تزعمه وأسس له الباحث السنغالي «أنتاجوب»، ينادي بالأصل الإفريقي للحضارة المصرية، مدللاً على ذلك بالعديد من الشواهد الجيولوجية واللغوية والأنثروبولوجية والتاريخية، وذلك بغية التصدي للاتهامات الغربية الاستعمارية للقارة الإفريقية والأفارقة بالتخلف وعدم الإسهام الحضاري، حيث رأى «أنتاجوب» أن ما أثبته في كتاباته وبحوثه من أصول إفريقية للحضارة المصرية يمثّل ركيزة أساسية في حرب إثبات الذات الإفريقية؛ في مواجهة مساعي المسخ والطمس التي مارسها ويمارسها الغرب في مواجهة الأفارقة وكل ما هو أسود (9).
ثانياً: تجليات فكرة الوحدة الإفريقية ومآلاتها بعد الاستقلال:
تكشف تجليات فكرة الوحدة الإفريقية في مرحلة ما بعد الاستقلال عن هوّة واضحة بين رغبات الشعوب الإفريقية في ترجمة الكفاح ضد الاستعمار بالقضاء على مواريثه، وفي مقدمتها واقع التجزئة والتفتت، ومخاوف بعض قيادات الدول حديثة الاستقلال – آنذاك – على مكاسبهم الشخصية، وطموحاتهم ضيقة الأفق والنطاق في الزعامة والرئاسة، وهو ما تجلّى في مواقف ثلاثة متمايزة بشأن فكرة الوحدة والتنمية، وهو ما نفصّله في السطور الآتية.
أ – فكرة الوحدة لدى التنظيمات الشعبية:
جسّدت مؤتمرات الهيئات غير الحكومية – مثل منظمة الشعوب الإفريقية – قيم الوحدة الإفريقية وأفكارها في صورتها المثالية، حيث تواترت قرارات تلك المؤتمرات على المناداة بالوحدة الإفريقية الشاملة، موضّحة السبل والإجراءات اللازم القيام بها لتوضيح ذلك، ومن الأمثلة الدالة على هذا المقام القرارات التي تواتر صدورها عن مؤتمر شعوب إفريقيا عبر دوراته الثلاث التي عُقدت في أكرا 1958م، وتونس 1960م، والقاهرة 1961م، فيما يتصل بالوحدة والتضامن (10).
ففي البيان الصادر عن مؤتمر شعوب إفريقيا المنعقد بالقاهرة في مارس 1961م، تم تأكيد ضرورة إنشاء شركة نقل بين الدول الإفريقية لتسهيل السفر وتبادل البضائع بينها، وإنشاء بنك إفريقي للاستثمار لتسهيل تنفيذ خطط التنمية، وعقد اتفاقات جمركية، واتفاقات دفاع جماعية لتنمية التبادل الاقتصادي؛ بما يمهّد لإقامة السوق الإفريقية المشتركة.
وفيما يتصل بالوحدة والتضامن؛ أشار البيان إلى أن الوحدة يجب أن تكون نابعة من إرادة شعوب إفريقيا المعبّر عنها تعبيراً حراً، وأنه من الواجب على جميع الدول والمنظمات الإفريقية أن تُظهر إرادة جماعية حقيقية في الوحدة.
وأشار البيان إلى أنه؛ نظراً إلى أن الإمبريالية والاستعمار الجديد يعملان بطريق مباشر، وغير مباشر، لتقسيم الدول الإفريقية، وخلق عقبات حقيقية تقف في سبيل تحقيق الوحدة وتأكيد الشخصية الإفريقية، يوصي المؤتمر جميع حكومات الدول الإفريقية بإنشاء (11):
1 – مجلس استشاري إفريقي: يتكون من أعضاء يمثّلون برلمانات الدول المستقلة، وتكوين سكرتارية دائمة، ويعقد جلسات دورية بغية وضع سياسة مشتركة تنتهجها الدول الإفريقية.
2 – مجلس للدول الإفريقية: يُعهد إليه دراسة توصيات المجلس الاستشاري وتنفيذها، خصوصاً فيما يتعلق بمسائل السياسية الخارجية.
3 – لجنة من الخبراء الأفارقة: لوضع الأسس لسياسة اقتصادية مشتركة، وذلك بغية النهوض بالوحدة السياسية الإفريقية ودعمها، وعلى شرط أن تقوم أسس هذه المجموعة الاقتصادية على تنسيق خطط التنمية في كل دولة؛ بغية تغيير الأنظمة القائمة وتوحيدها.
4 – لجنة من القادة العسكريين الأفارقة: يُعهد إليها دراسة دفاع إفريقي مشترك وتحديده وتنظيمه.
5 – لجنة ثقافية: لوضع سياسة إفريقية لشؤون التعليم والتبادل الثقافي.
ب – مآلات فكرة الوحدة على الصعيد الرسمي:
وعلى الرغم من تلك القرارات، وبالرغم من نضال الرئيس نكروما من أجل الحصول على موافقة الدول الإفريقية على تكوين اتحاد سياسي من جميع الدول الإفريقية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، ودفاعه عن ضرورة وجود (منظمة سياسية مركزية) تضم مجلس شيوخ ومجلس نواب لهما سلطة وضع سياسة خارجية مشتركة، وتخطيط قاري مشترك للتنمية الاقتصادية والصناعية، وخطة عمل مشتركة، ومنطقة نقدية(12)، ومصرف نقدي، ونظام دفاع مشترك(13) ، فإن مساعي الوحدة الإفريقية القارية أسفرت في النهاية فقط عن قيام منظمة الوحدة الإفريقية بوصفها مظلة للعمل الإفريقي، ومحصلة للإرادات المستقلة للدول الإفريقية التي حرصت جميعها على الحفاظ على استقلالها وسيادتها؛ حيث أكد ميثاق الوحدة الإفريقية في بنوده احترام سيادة الدول الإفريقية، واحترام سلامتها الإقليمية، وكذا المساواة بين دول القارة، الأمر الذي جسّد الاعتراف بواقع التعدد والاستقلال بين الدول الإفريقية.
ج – البدائل القطرية لفكرة الوحدة الإفريقية:
ومع إخفاق مساعي قيام الولايات المتحدة الإفريقية؛ اجتهد بعض قيادات القارة في تبنّي النّظم الفكرية الغربية والشرقية بوصفها سبلاً للتقدم والتنمية، وسعى آخرون إلى بلورة مشاريع فكرية تنموية خاصة؛ من ذلك – على سبيل المثال – مشروع «الأوجاما» الذي بلوره الرئيس التنزاني الأسبق «جوليوسنيريري»، والذي يقوم في جوهره على بعث بعض التقاليد الإفريقية والتعاونيات الجماعية وإحيائها، فبعد التعبير عن معارضته للأيديولوجيات الغربية والشرقية وأساليب تطورها؛ أوضح «نيريري» أفكاره الخاصة فيما يتعلق بعملية التنمية والتطور في تنزانيا؛ مؤكداً أن إفريقيا لم تعد بحاجة إلى الاشتراكية، ولا لمن يعلّمها الديمقراطية؛ لأنهما موجودتان منذ الأزل في ماضيها، في مجتمعاتها «التقليدية»، فبوسع الاشتراكية الإفريقية الحديثة – من وجهة نظره – أن تستقي من تقاليدها الموروثة مبدأ الاعتراف بالمجتمع بوصفه امتداداً لوحدة العائلة، غير أنه لم يعد في مقدورها المضي في حصر فكرة المجتمع العائلي في إطار القبيلة، أو حتى الأمة (14).
على أن تلك المساعي الفكرية القُطْرية لم تُثبت كثير نجاح بدورها، لإخفاق النّظم التي تبنتها في تحقيق وعودها التنموية في أرض الواقع، وتزايد نزعات القمع ومصادرة الحريات ، الأمر الذي أفسح المجال من جديد لجولة جديدة من الأفكار والمساعي التكاملية والوحدوية بوصفها سبيلاً لمواجهة التحديات التي واجهتها القارة منذ نهاية الثمانينيات من القرن العشرين في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي، والتحولات في أوروبا الشرقية، وتصاعد نغمة الحديث عن ازدياد تهميش إفريقيا.
ثالثاً: من الوحدة إلى الاتحاد والنهضة والحكم الرشيد:
يكشف رصد حركة الفكر السياسي القاري في إفريقيا عن قدر من التشابه والاختلاف بين مرحلة القطبية الثنائية (الحرب الباردة، أو بعبارة أخرى ما قبل سقوط الاتحاد السوفييتي والتحولات في النظام العالمي الجديد)، ومرحلة ما بعدها من تحولات.
وإجمالاً؛ يمكن القول إن ملامح التشابه تتمثل في الخطوط العريضة للفكر السياسي ومداخل الإصلاح، حيث استمرت الخطوط المتوازية الثلاثة لمداخل الإصلاح في القارة، والمتمثلة في :
– المدخل القاري (من الوحدة إلى الاتحاد).
– المدخل الإقليمي (التكامل الفرعي).
– وأخيراً المدخل القُطْري (الإصلاح الداخلي).
وتمثّلت أبرز مظاهر الاختلاف بين المرحلتين في بعض المضامين الخاصة بكل مدخل من تلك المداخل، فمع بقاء فكرة الدولة والنظام السياسي مركزية في فكر الإصلاح والوحدة والنهضة؛ فإنها تنازلت عن بعض سطوتها لصالح خطاب الديمقراطية؛ بفعل انتشار مفاهيم حقوق الإنسان والحكم الرشيد بما يتضمنه من مشاركة ومساءلة وشفافية وحسن إدارة.. والتي مثّلت استجابة لضغوطات العولمة، ونقلة في مضامين الفكر السياسي على الساحة الإفريقية، وفيما يلي تفصيل ذلك.
أ – من الوحدة إلى الاتحاد الإفريقي.. تفاعل الفكر والواقع:
يمثّل قيام «الاتحاد الإفريقي» ترجمة لتفاعل الفكر السياسي والواقع على الساحة الإفريقية، فطوال العقود التالية لإنشاء «منظمة الوحدة الإفريقية» لم يتخل دعاة الوحدة الإفريقية من المفكّرين والساسة عن طموحهم في إقامة كيان اتحادي أكثر قوة يضم دول القارة الإفريقية بأكملها، ويرعى مصالحها.
وقد جرت عدة محاولات لتعديل ميثاق «منظمة الوحدة الإفريقية»، كان من أبرزها قرارات القمة الإفريقية عام 1979م بإنشاء لجنة لمراجعة ميثاق «منظمة الوحدة الإفريقية»، ثم في عام 1991م، وفي خلال القمة السابعة والعشرين، تم توقيع «اتفاقية أبوجا» المؤسِّسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بنيجيريا، علاوة على المشروع الذي طرحه رئيس نيجيريا السابق «أوبا سانجو» بإقامة منتدى لمناقشة قضايا التعاون والتنمية والاستقرار