تأليف/ تويين فالولا و إيمانويل إم مباه
إعداد/ دعاء عبد النبي حامد
باحثة دكتوراه تخصص فلسفة إفريقية حديثة ومعاصرة- كلية الآداب جامعة القاهرة – مصر
مقدمة عامة حول الكتاب:
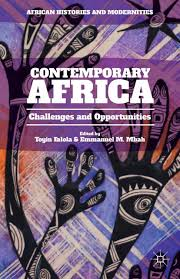 يُعدّ كتاب “إفريقيا المعاصرة: التحديات والفرص”([1])، أحد الإسهامات المهمة في تحليل واقع القارة الإفريقية خلال الحقبة المعاصرة.
يُعدّ كتاب “إفريقيا المعاصرة: التحديات والفرص”([1])، أحد الإسهامات المهمة في تحليل واقع القارة الإفريقية خلال الحقبة المعاصرة.
يتألف الكتاب من أحد عشر فصلًا، تتوزع على محاور متعددة، تشمل القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على إرث الاستعمار، الصراعات الداخلية، الفقر، التنمية، التعليم، والحوكمة. كما يستعرض الفرص المتاحة لإعادة بناء القارة وفق أُسُس تنموية عادلة ومستدامة.
ينتمي هذا العمل إلى سلسلة الكتب الأكاديمية التي تُوظِّف الأدوات التاريخية والتحليلية لفَهْم الحاضر في ضوء الماضي، ويُمثّل جهدًا توثيقيًّا وفكريًّا لفَهْم “إفريقيا ما بعد الاستقلال”، بكلّ ما تحمله من تناقضات وإمكانات.
أهم الأفكار والمحاور الأساسية:
– إرث الاستعمار في إفريقيا؛ يُوضِّح كيف أثَّر الاستعمار في تشكيل الأنظمة السياسية والاقتصادية بعد الاستقلال. كما يبحث في الطرق التي لا تزال البنى الاستعمارية تؤثر بها في مؤسسات الدول.
– النظم السياسية والتحولات الديمقراطية؛ يناقش النضال من أجل بناء مؤسسات ديمقراطية قوية. كما يتناول التحديات السياسية مثل الاستبداد، الفساد، والصراعات الانتخابية.
– النمو الاقتصادي والتنمية؛ يعرض العقبات التي تعرقل التنمية الاقتصادية. يناقش دور العولمة، والمساعدات الخارجية.
– العنف والنزاعات المسلحة؛ يُحلّل الأسباب البنيوية للنزاعات (الإثنية، الموارد).
– قضايا الصحة والأمراض الوبائية؛ يناقش التحديات التي تُواجه الأنظمة الصحية الإفريقية.
– يبحث في الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمرأة، ويعالج قضايا التمييز والعدالة.
– الهجرة والشتات؛ يستعرض ظاهرة الهجرة الداخلية والخارجية، وآثارها السلبية على القارة الإفريقية.
– البيئة والاستدامة؛ يعالج مشكلات مثل الجفاف، التصحر، والتغيُّر المناخي. ويناقش العلاقة بين الاستغلال البيئي والفقر.
– إفريقيا: إلى أين؟ يطرح آفاق المستقبل في ضوء التحديات والفرص، ويركّز على الشباب، التكنولوجيا، والتكامل الإقليمي.
منهجية الكتاب:
اعتمد الكتاب على عدة منهجيات لتوضيح الأفكار المطروحة:
– منهج تحليلي: اعتمد الكتاب على التحليل لتوضيح الأفكار الضرورية التي يهدف الكتاب إلى دراستها؛ سواء الإرث الاستعماري، أو المشكلات التي تواجهها القارة بسبب هذا الإرث.
– مقاربة تاريخية: استحضر المؤلفان السياق الاستعماري وما بعد الاستعمار لتوضيح أثره في القضايا والتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية.
– منهج مقارن: يقدم الكتاب مقارنات بين نماذج الحالة المقدَّمة لتسليط الضوء على أوجه التشابه بينهم.
– تهدف المنهجية إلى تقديم صورة واقعية عن “القارة المعاصرة”، مع الحفاظ على توازن بين التفسير التاريخي والتفكيك السوسيولوجي والسياسي. كما يظهر بوضوح توجُّه نقدي تجاه كلّ من النخب الإفريقية والمؤسسات الدولية المهيمنة، مما يمنح الكتاب طابعًا تحرريًّا ومناهضًا للاستعمار الجديد.
ينقسم الكتاب إلى جزأين؛ الجزء الأول يحمل عنوان “الإرث الاستعماري والاستعماري الجديد”، وهو مكوّن من أربعة فصول بعد الفصل التمهيدي. والجزء الثاني يحمل عنوان “لحظات التحول في الاقتصادات والثقافات”، وهو مكوّن من ستة فصول، والكتاب في مجمله مكوّن من أحد عشر فصلًا. والكتاب مساهمة علمية لعدة باحثين.
الفصل الأول:
تمهيد بعنوان “التغيير والاستمرارية في إفريقيا المعاصرة”. بواسطة المحررين تويين فالولاToyin Falola ، إيمانويل إم مباه. Emmanuel M. Mbah
يبدأ الفصل بتوضيح أنه على الرغم من استقلال الدول الإفريقية إلا أن هذا الاستقلال لا يُبشِّر بالتفاؤل؛ وذلك لأن الدول الإفريقية لا تزال تجد صعوبة في إنشاء مؤسسات حكم ديمقراطية هادفة قادرة على القضاء نهائيًّا على الفساد والمحسوبية غير المبرّرة؛ وفي بناء اقتصادات تعتمد على الذات وقادرة على سدّ فجوة الفقر وتلبية الاحتياجات التنموية لشعوب القارة؛ وفي إنشاء هياكل اجتماعية ملموسة تُرَكِّز على تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة والنهوض بالتعليم والرعاية الصحية.
ولأن السلطات الاستعمارية لم تُبْدِ سوى وُعود لفظية لهذه القضايا الاجتماعية والاقتصادية وغيرها؛ فقد ورث رجال الدولة الأفارقة قارة تعاني من سلسلة من التحديات التي تكاد تكون مستعصية على الحل. إن عجزهم عن التعامل مع هذا الكَمّ من المشكلات دفعة واحدة يُمَثِّل دليلًا على الخلل الوظيفي الذي لا يزال يُصيب هذه الدول الناشئة حتى يومنا هذا.
التحديات أشد وطأةً؛ لأن الخلافات الشخصية والانقسامات العرقية التي نشأت خلال فترة الحكم الاستعماري أدَّت إلى العديد من النزاعات وعرقلت الحوار بين الدول وداخلها. وهكذا، فإن الوعود العديدة التي قُطِعَت خلال النضال من أجل الاستقلال، مثل القضاء على الجوع والفقر؛ وتحسين الرعاية الصحية والمرافق والخدمات التعليمية؛ والتحديث من خلال توسيع البنية التحتية، وخلق فرص العمل والعديد من المشاريع الأخرى التي كان من المفترض أن تعمل على تحسين مستويات المعيشة في القارة، لم تتحقق أبدًا.
وعلى الرغم من أنه طرأ بعض التحسُّن في الصناعة والبنية التحتية والسفر والتعليم والمشاريع المُطَوَّرة داخليًّا، بالإضافة إلى توسيع المؤسسات الديمقراطية، ولا سيما الدور المتزايد للمجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ إلا أن الإرث الاستعماريّ لا يزال يُمَثِّل مشكلةً، لا سيما وأن الاقتصادات الإفريقية لا تزال تعتمد على الغرب والصين، اللذين يُمليان في كثير من الأحيان ما يجب إنتاجه وحصص الإنتاج والأسعار. كما تعتمد الاقتصادات الإفريقية بشكلٍ مُفرط على العالم المتقدّم في التكنولوجيا والمهارات والخبرة. ونتيجة لذلك، لا تزال موارد القارة، كما كانت في عهد الاستعمار، تُنْقَل إلى الخارج بأشكال مختلفة: مبيعات المواد الخام؛ وارتفاع أسعار الواردات؛ وخدمة القروض التي لا تنتهي.
يطرح الفصل عدة تحديات تواجه القارة الإفريقية، من أهمها ما يلي:
– مشكلة الديون، والتي تُشَكِّل تحديًا كبيرًا وأحد المعوقات الرئيسية للتنمية في إفريقيا المعاصرة. وتُسَجِّل إفريقيا أعلى مستوى من الديون الخارجية “بالنسبة إلى الناتج الاقتصادي”. أيضًا البطالة والفقر الناتج عن الفشل الذريع عن السياسات الاقتصادية وكثرة الديون.
– مشكلة المرأة والفقر والتمييز بين الجنسين؛ حيث تُعتبر النساء أشد الفئات معاناة من الفقر والجوع، ولأن عددًا أكبر من النساء في القارة غير متعلمات، فإن وصولهن إلى الموارد الاقتصادية محدود، ويتفشى الفقر بينهن، وخاصة في المناطق الريفية. ثانيًا، في أجزاء كثيرة من القارة، لا تُفَضّل الممارسات الثقافية التقليدية، أن تُنظّم النساء حيازة الأراضي وملكيتها. تُشكّل هذه الممارسات عائقًا كبيرًا أمام التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في إفريقيا.
– الرعاية الصحية؛ لا تزال الرعاية الصحية تُشكّل عائقًا رئيسيًّا أمام التنمية والتقدم الاجتماعي للعديد من الدول الإفريقية، سواء من حيث الموارد المُنفَقة لعلاج الأمراض أو آثارها المُنهِكة على الصحة والإنتاجية في القارة. ولكن على الرغم من التحدي الذي تواجهه القارة في مجال الرعاية الصحية، والذي يكاد يكون من المستحيل التغلب عليه، لا تزال البنى التحتية الصحية غير كافية وبالية، وأنظمة تقديم الخدمات غير فعَّالة.
– وفيات الأطفال وصحة الأم؛ رغم تحسُّن معدلات وفيات الأطفال في إفريقيا، لا يزال عدد أكبر من الأطفال الأفارقة يعانون من المرض والجوع وسوء التغذية مقارنةً بالأطفال في مناطق أخرى من العالم.
– الاستدامة البيئية؛ القارة الإفريقية غنية بالموارد الطبيعية، إلا أن مواردها تُستنزَف بمعدل يُنْذِر بالخطر. إن تزايد إزالة الغابات في العديد من بلدان غرب ووسط إفريقيا هو نتيجة، جزئيًّا، لأنشطة قطع الأشجار التي تقوم بها الشركات المحلية والأجنبية، ولكنْ أيضًا نتيجة للحاجة المحلية لحطب الوقود بسبب عدم وجود مصادر بديلة للوقود. وقد أدَّت إزالة الغابات إلى تدمير التربة السطحية ممَّا أدَّى إلى تآكل التربة. وقد أدَّى استغلال النفط إلى العقبات التي تعترض معالجة تحديات التنمية والنمو الاجتماعي.
يطرح المؤلف ثلاث عقبات رئيسية تعترض سبيل إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها إفريقيا المعاصرة. وتشمل هذه العقبات: السياسات العرقية، وغياب الحكم الرشيد، والصراعات، والتمردات، والإرهاب، وتدمير العديد من الأراضي المستدامة حتى الآن في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
تُؤطِّر هذه المقدمة مفهوم التغيير والاستمرارية في إفريقيا المعاصرة في سياق تحدياتها وفرصها. بينما تنقسم التسعة فصول الباقية إلى قسمين رئيسيين؛ الجزء الأول: الإرث الاستعماري والاستعماري الجديد، والجزء الثاني: لحظات التحوُّل في الاقتصادات والثقافات. وتُلَخِّص خاتمة الفصل الحادي عشر مناقشات المساهمين. تتناول فصول كل قسم الأفكار المحددة في المقدمة. ويتناول الجزء الأول الإرث الاستعماري والاستعماري الجديد، ويتألف من أربعة فصول.
الفصل الثاني:
اختراعات وإعادة الاختراعات ماو ماو. بواسطة: ميكي موانزيا كوسترMickie Mwanzia Koster
يستكشف الفصل “اختراعات وإعادة اختراع الماو ماو”، بقلم ميكي موانزيا كوستر، تشابكات الأدب المتعلق بالماو ماو على مدى السنوات الخمسين الماضية. ويجادل بأن النصوص المحيطة بالماو ماو في الأرشيفات الاستعمارية بمثابة دليل واضح على استخدامات وإساءة استخدام التاريخ وصنع التاريخ. ويرجع ذلك إلى أن الحرب تم خوضها في الغابات وفي المطبوعات، مما شكَّل الصور والخيالات والسرديات المحيطة بالموضوع.
يشير الفصل إلى أن سرديات الماو ماو لا تزال تُخلَق وتُستخدَم في المجالات السياسية والاجتماعية في كينيا وخارجها. ونتيجة لذلك، يجُادل الفصل بأنه لا توجد نسخة واحدة لسردية الماو ماو؛ بل هناك ماضٍ ذو نوافذ متعددة ومتغيرة. لذا، بدلًا من البحث عن نَهْج أحادي البعد لتمثيل تاريخ الماو ماو، سيتعين على المؤرخ البحث عن منهجيات أكثر إبداعًا وتعددًا في الأبعاد لتفسير تعقيده.
يقدم هذا الفصل معالجة مُركّزة لتعقيد وتناقض تأريخ الماو ماو، من خلال دراسة كيفية “تكييفه” مع مرور الوقت مِن قِبَل مجموعات مختلفة. ويتضمن هذا السرد خطابًا حول السلطة والقدرة على خلق سرديات تاريخية تناسب المصالح السياسية وأجندات ذلك العصر. ومن المثير للاهتمام أن سرديات الماو ماو لا تزال تُخلَق وتُستخدَم في الفضاءات السياسية والاجتماعية في كينيا وخارجها. ويجادل المؤلف بأنه لا توجد نسخة واحدة لسردية الماو ماو؛ بل يوجد فقط ماضٍ ذو نوافذ متعددة ومتغيرة. لذا، بدلًا من البحث عن نَهْج أحادي البُعد لتمثيل تاريخ الماو ماو، سيتعين على المؤرخ البحث عن منهجيات أكثر إبداعًا وتعددًا في الأبعاد لشرح تعقيده.
يقدم الفصل نظرة عامة على تاريخ الماو ماو؛ حيث كان نضال الماو ماو لحظة تاريخية؛ فقد اتحد العديد من الكينيين احتفاليًّا من خلال القسم المقدس للقتال من أجل استقلالهم. وهي ثورة دامت ثماني سنوات. مَثَّلت سنوات الحرب الثماني (من عام ١٩٥٢ إلى عام ١٩٦٠م) من نواحي عديدة فترة أصبح فيها الكينيون كينيين مستقلين. تجاوزت الحركة حدود العرق والجنس والطبقة والتعليم والدين والموقع الجغرافي. ورغم أن أغلب أفرادها من الكيكويو، إلا أن حركة الماو ماو مثَّلت حراكًا جماعيًّا ضد الوضع المتفاقم المتمثل في تجاهل الإدارة الاستعمارية البريطانية للمظالم. كانت حركة سرية، معظم عملياتها في غابات وسط كينيا؛ حيث تعهد المجنّدون بالقتال وطرد البريطانيين من كينيا. لقد كانت الحرب وحشية.
يوفر النقاش في هذا الفصل نافذة صغيرة على بعض المحادثات والقضايا والنزاعات بين المجموعات المختلفة لإظهار وجهات النظر المتنوعة التي دخلت في صنع وإعادة صنع تأريخ الماو ماو. هذه النزاعات هي أمثلة على طبقات الآراء والمعاني والمشكلات في فهم الماو ماو. وبالتالي، كان تأريخ الماو ماو، منذ نشأته، مساحة للاختراع وإعادة الاختراع التاريخي من أجل دعم المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتنوعة. لذلك، سيكون هذا الفصل بمثابة أساس ضروري لفهم الماو ماو وتحدياتها الخطابية؛ كما يكشف كيف تم تشكيل إنتاج المعرفة حول هذا الموضوع من خلال تشابكات السلطة السياسية والعِرْق والذاكرة في كينيا. لا تزال الماو ماو مُحيّرة لأن السرديات لا تزال تتطوَّر، يتم اختراعها وإعادة اختراعها باستمرار مِن قِبَل مختلف مفسري الماو ماو.
يطرح الفصل الروايات المتعددة سواء روايات من أعضاء مشاركين في الحركة أو الروايات الاستعمارية حول حركة الماو ماو، والتي لم تكن حركة واحدة، بل حركات متعددة وفقًا لما ورد في الفصل، ويختتم الفصل بأن قصة الماو ماو لم تنتهِ بعدُ؛ وسيكون هناك المزيد من الاختراعات وإعادة الاختراع لهذا التاريخ. إنه تاريخ لم يُحْسَم بعدُ، ولم تنكشف حقيقته بالكامل. ويعود ذلك بشكلٍ خاصّ إلى القمع المتعمّد للأدب؛ ففي أعقاب النضال، مُنِعَ مقاتلو الماو ماو من التجمع. والكشف مؤخرًا عن آلاف الملفات المتعلقة بالماو ماو فتح الباب أمام روايات جديدة. بعد سنوات من التحقيقات القانونية، عاد قدامى الماو ماو السابقون إلى محاكم لندن، سعيًا هذه المرة إلى تسوية خارج المحكمة للفظائع البريطانية المُرتَكَبة ضدهم في خمسينيات القرن الماضي.
الفصل الثالث:
تطوير الخدمة المدنية في إفريقيا. بواسطة: يوليوس أو. أديكونلي Julius O. Adekunle
يجادل الفصل بأن نظام الخدمة المدنية الإفريقي سبق الحكم الاستعماري، وأنه كان موجودًا في فترة ما قبل الاستعمار. وعلى مدار عدة سنوات من وجوده كجهاز حكومي، خضعت الخدمة المدنية لتغييرات وتحسينات وإصلاحات. حدث أول تغيير كبير مع مجيء الأوروبيين، الذين أدخلوا نظام الخدمة المدنية الغربي. أدَّى هذا التغيير إلى عملية تكيُّف من جانب الأفارقة. تغيَّرت متطلبات الوظائف في الخدمة المدنية؛ حيث كان التعليم الغربي ضروريًّا للتمكن من أداء الوظائف متعددة الأبعاد في الخدمة المدنية. ومع إنشاء إدارات جديدة، اتسع نطاق الخدمة المدنية، وزاد عدد موظفي الخدمة المدنية. وبالتالي، أصبحت الحكومة جهة توظيف رئيسية وارتفعت نفقات الحفاظ على الإدارة. ومن المُسلَّم به أن نظام الخدمة المدنية الحديث هو إرث من الحكومة الاستعمارية.
وبينما يُعدّ مفهوم الخدمة المدنية ظاهرة عالمية، إلا أن تطوُّرها في إفريقيا سبق الحقبة الاستعمارية. فقد اعتمدت الممالك والإمبراطوريات الإفريقية على أنظمة ملكية، وكانت هناك مؤسسات سياسية، بالإضافة إلى حلقة من المسؤولين الذين قدموا خدمات حكومية متنوعة نيابة عن الحاكم. وأحاط الحكام الأفارقة أنفسهم بأشخاص أكفاء شكّلوا جوهر الخدمة المدنية قبل الاستعمار.
يتناول هذا الفصل نشأة الخدمة المدنية ونموّها في إفريقيا. ويناقش كيف أيَّد النظام السياسي المركزي الحجة القائلة بأن الأفارقة كانوا يمتلكون مفهوم الخدمة المدنية قبل أن يفرض الأوروبيون نظامًا حكوميًّا غربيًّا. وحتى في غياب الأنظمة المركزية، طوّر الأفارقة مؤسسات حلَّت محل الخدمة المدنية. وبدراسة عولمة الخدمة المدنية، يشرح الفصل كيف تكيَّف الأفارقة مع التغيُّرات السياسية، وكيف تمركزوا في نظام الخدمة المدنية الذي أدخله الأوروبيون. كما سيُحلّل وَضْع الخدمة المدنية في إفريقيا المعاصرة.
الحكومة والخدمة المدنية في إفريقيا ما قبل الاستعمار؛ يطرح المؤلف في هذا الفصل نظام الحكومة والخدمة المدنية في العديد من الإمبراطوريات الإفريقية ما قبل الاستعمار، ومن بين هذه الإمبراطوريات: إمبراطوريتا كانم-برنو في غرب إفريقيا الحالية، في جنوب غرب نيجيريا؛ حيث كانت إمبراطورية أويو قائمة، كانت إمبراطورية أشانتي في غرب إفريقيا. وعلى نحو مماثل، في منطقة البحيرات (شرق ووسط إفريقيا)، برزت مملكة بونيورو كنظام سياسي كبير ومنظَّم بشكل جيد “حتى تطوَّر إلى دولة أكثر مركزية وبيروقراطية في بوغند.
في النظام الحكومي في جميع أنحاء الدول المركزية في إفريقيا، كان الملك يعمل بتناغم مع مجلس الزعماء وغيرهم من المُعينين مِن قِبَل الدولة. وكان يُعالَج أيّ عصيان أو تمرد على الفور، وتُبْذَل محاولات لمنع التمرد. وبدون تعاون وكفاءة نواة “موظفي الخدمة المدنية”، لم يكن الملك ليتمكّن من الحفاظ على القانون والنظام والحكم بسلام. على الرغم من أن المجتمعات الإفريقية كان يهيمن عليها الرجال، إلا أن كلا الجنسين شاركا في السياسة وتبوآ مناصب سياسية. مع ذلك، لعبت النساء أدوارًا مختلفة ومتكاملة.
بخلاف الدول المركزية، لم تكن المجتمعات عديمة الجنسية تعمل بنظام سياسي معقّد، بل كان لديها موظفون حكوميون، يعتمدون بشكل أساسي على القرابة وحكم الشيوخ. وبدلًا من الملك، كان العديد من رؤساء العشائر أو السلالات يُقدّمُون للقيادة، وإن لم تكن لديهم سلطة سياسية مؤسسية. ومن الأمثلة على المجتمعات عديمة الجنسية: الإيغبو Igbo والتيف Tiv في نيجيريا، والدينكا Dinka والنوير Nuer في السودان، والماساي Maasai في كينيا، والتالينسي Tallensi في غانا الحديثة. في هذه المجتمعات، كان المفهوم الاجتماعي والسياسي السائد هو المساواة.
كانت جميع جوانب النظام السياسي قائمة بحلول نهاية القرن التاسع عشر عندما اخترق الأوروبيون المناطق الداخلية من إفريقيا. وكان هدفهم هو القضاء على تجارة الرقيق من جذورها في إفريقيا وإدخال التجارة المشروعة. ونظرًا لنمو وانتشار الثورة الصناعية والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية في أوروبا، كان هناك بحث عن المواد الخام والأسواق لسلعهم المصنعة في إفريقيا. وأدَّى تدفُّق التجار والشركات الأوروبية إلى تنافس اقتصادي شديد، ومنافسة على الاستحواذ على الأراضي، وإنشاء مناطق نفوذ. وتحوَّلت العلاقات الاقتصادية الأولية بين الأفارقة والأوروبيين لاحقًا إلى سيطرة سياسية، مما أدَّى في النهاية إلى تغيير الأنظمة السياسية الموجودة مسبقًا في إفريقيا. ومع تولّي الأوروبيين السلطة السياسية، تم إدخال مؤسسات سياسية جديدة. وهكذا، تحوَّل الأفارقة من نظامهم الملكي إلى نظام برلماني أوروبي مع إدخال الخدمة المدنية.
كان إضفاء الطابع الإفريقي على الخدمة المدنية في إفريقيا المستعمرة قضية سياسية رئيسية خلال فترة إنهاء الاستعمار. ولإثبات كفاءة الأفارقة في إدارة شؤونهم بأنفسهم، شرع القادة السياسيون الناشئون في عملية توطين الخدمة المدنية بالدعوة إلى استبدال مسؤولي الاستعمار بأشخاص أفارقة متعلمين قادرين على أداء المهام الإدارية. ومع استقلال الدول الإفريقية، وخاصة بحلول منتصف القرن العشرين والنصف الثاني منه، كان من أبرز الإصلاحات المباشرة إضفاء الطابع الإفريقي على نظام الخدمة المدنية، الموروث عن الأوروبيين. ومع ذلك، لا تزال الخدمة المدنية، آنذاك والآن، تؤدي وظائف “تصميم وصياغة وتنفيذ السياسات العامة”. كما أنها “تؤدي مهام الحكومة وبرامج التنمية بكفاءة وفعالية”. كما هو الحال بالنسبة للقطاعات الحكومية الأخرى، تقوم الخدمة المدنية بإجراء إصلاحات من وقتٍ لآخر من أجل تحسين أدائها وجعل سياساتها ذات صلة باحتياجات الشعب.
واجهت الخدمة المدنية في إفريقيا تحديات عديدة:
أولًا: بعد فترة وجيزة من نيل الاستقلال، تم توظيف العديد من الأفارقة في الخدمة المدنية بسبب سياسة الأَفْرَقَة. انضم معظم خريجي الكليات والجامعات إلى الخدمة المدنية نظرًا لظروف العمل الجذابة ظاهريًّا، فأصبحوا بمثابة “الطبقة البرجوازية البيروقراطية، ومع تزايد أعداد العاملين بالخدمة المدنية أصبح تدريب وصيانة الخدمة المدنية الضخمة يفرض أعباء اقتصادية على العديد من الحكومات.
ثانيًا: نظرًا لوصولهم إلى الأموال العامة، أصبح العديد من موظفي الخدمة المدنية فاسدين. فالمقاولون على استعداد لدفع الرشوة من خلال موظفي الخدمة المدنية للحصول على عقود، وأصحاب الأعمال مصممون على تقديم رشاوى لتقليل تكاليف التشغيل. وبينما يُعدّ الفساد وسيلة لاستدامة الاقتصاد، إلا أنه لا يزال ظاهرة عالمية، وهو مُتفَشٍّ في العديد من الاقتصادات المتخلفة، بما في ذلك الدول الإفريقية.
ثالثًا: تغلغلت المحسوبية إلى حدّ كبير في الخدمة المدنية. وأصبحت الهويات العرقية، وليس القدرة أو المهارات اللازمة للأداء، هي العامل الرئيسي في اختيار من يشغلون المناصب العامة. ويبدو أن هناك دوافع سياسية وراء ذلك.
الفصل الرابع:
الحرب العالمية الثانية والبنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا: دراسة حالة لشبكة السكك الحديدية النيجيرية. بواسطة: توكونبو أ. أيولا Tokunbo A. Ayoola
يتناول الفصل تأثير الحرب العالمية الثانية على البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا. ويناقش أيولا، -مستخدمًا السكك الحديدية النيجيرية كدراسة حالة-، أن الأثر السلبي للحرب على الشبكة يفوق بكثير الفوائد الناجمة عن الانتعاش الاقتصادي المؤقَّت الذي أحدثه الصراع. ويجادل أيولا بأن بعض اللوم في تردّي حالة البنى التحتية في إفريقيا بعد الاستعمار يعود إلى ركودها شبه الكامل خلال سنوات الحرب.
في بداية الحرب العالمية الثانية، كانت معظم أجزاء إفريقيا تحت سيطرة القوى الاستعمارية الأوروبية. وهكذا، جر مستعمروها إفريقيا والأفارقة إلى الصراع؛ حيث حشدوا موارد القارة وبِنْيتها التحتية للحرب. استخدمت دول الحلفاء، التي سيطرت على القارة طوال فترة الحرب، البنى التحتية للنقل في إفريقيا على نطاق واسع لنقل القوات والإمدادات والآلات إلى أجزاء من إفريقيا وخارجها. بعد خسارة المستعمرات البريطانية في جنوب شرق آسيا أمام اليابان في أوائل أربعينيات القرن العشرين، أصبحت إفريقيا فجأة ذات أهمية إستراتيجية كبيرة بالنسبة لقوى الحلفاء، وخاصةً فيما يتصل بتوفير المواد الخام الأساسية (الفول السوداني، وزيت النخيل، والكاكاو، والمطاط، والقطن) والموارد المعدنية التي استُخدمت لإطعام قُوّاتهم وإنتاج المواد الحربية على التوالي.
ونتيجةً لتزايد الطلب على هذه السلع، تعرَّض الأفارقة لضغوطٍ كبيرةٍ لإنتاج المزيد من المنتجات الزراعية والمعادن للتصدير. وهكذا، حفَّزت الحرب المزيد من الإنتاج، وأحدثت طفرة اقتصادية.
ومع ذلك، جاءت هذه التطورات على حساب البنية التحتية للنقل في القارة، التي استخدمت بكثافة ودون صيانة أو تجديد مناسبين. خلال الحرب، وأصبح من المستحيل استيراد السلع الرأسمالية الأساسية مثل قطع الغيار والآلات اللازمة لإصلاح وتحديث البنية الأساسية المادية القائمة. وكان ذلك نتيجة للسياسات الاستعمارية الاقتصادية والصناعية المتناقضة.
وبما أن المشاركة العسكرية لإفريقيا ومساهماتها في نتائج الحرب العالمية الثانية تُشكِّل جزءًا مهمًّا للغاية من تاريخ القارة الحديث، فقد كتب العديد من الباحثين عن هذه المساهمات وعن العواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والثقافية للحرب على إفريقيا وشعوبها. ولكن يغيب بشكلٍ واضحٍ في الأدبيات الحالية أيّ دراسة حول التأثير المحدد للحرب على البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا: السكك الحديدية والموانئ والمطارات والطرق والممرات المائية الداخلية. وبالتالي، فإن الغرض من هذا الفصل هو سدّ الفجوة في الأدبيات الحالية. باستخدام السكك الحديدية النيجيرية (NR) كدراسة حالة، يناقش هذا الفصل تأثير الحرب ويجادل بأن التأثير السلبي للحرب على نظام السكك الحديدية النيجيري يَفُوق بكثير الفوائد المُستمَدَّة من الطفرة الاقتصادية المؤقتة التي أتاحتها الحرب. كان أفضل مساعدة قُدِّمت إلى السكك الحديدية النيجيرية بعد الحرب هو إعادة تأهيل متدرجة لمعداتها وبنيتها التحتية، بدلًا من إعادة بنائها أو تحديثها بالكامل. ويجادل أيضًا بأن بعض اللوم في الحالة السيئة للبنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا بعد الاستعمار يمكن إرجاعه إلى ركودها الفعلي خلال سنوات الحرب، 1939 – 1945م.
أخيرًا، أجبرت الآثار التراكمية للحرب على السكك الحديدية الوطنية (NR) على التراجع وخسارة إيراداتها لصالح النقل البري منذ أواخر الخمسينيات فصاعدًا. إضافةً إلى ذلك، تراكمت خسائر تشغيلية على السكك الحديدية الوطنية، وأثقلت كاهلها بأعباء ديون متزايدة. لم تتعافَ من هذه التحديات في حقبة ما بعد الاستعمار، عندما أدركت الحكومة، إدراكًا منها لمشكلات السكك الحديدية الوطنية متعددة الأبعاد، وطبيعة عملياتها كثيفة رأس المال، وعجزها عن تلبية متطلبات النقل في البلاد بعد الحرب وبعد الاستقلال، واندفاعها المحموم لتطوير السكك الحديدية الوطنية بوتيرة أسرع بكثير من “صلابة موقع” السكك الحديدية النيجيرية. عانت عمليات السكك الحديدية النيجيرية من انحدار رهيب، وبحلول أوائل تسعينيات القرن العشرين، انهارت صناعة السكك الحديدية النيجيرية تقريبًا.
الفصل الخامس:
بعنوان “الحرب الباردة وظهور التباينات الاقتصادية: مقارنة بين إفريقيا وآسيا” بوسطة/ أس يو فواتشاك S. U. Fwatshak على التأثير الاقتصادي للحرب الباردة على إفريقيا وآسيا.
وعلى الرغم من أن المنطقتين لم تكونا فاعلتين رئيسيتين في الحرب الباردة، إلا أنهما شاركتا، وبالتالي تأثرتا بالحرب. فمن ناحية، خرجت آسيا من الحرب أفضل اقتصاديًّا؛ وعلى العكس فإن التباين في النتائج كان صحيحًا بالنسبة لإفريقيا. وبالتالي، بالنسبة لـFwatshak الحرب في المنطقتين يثير بطبيعة الحال أسئلة مختلفة، مثل ما الذي يُفسِّر التباينات الاقتصادية في نتائج الحرب الباردة في المنطقتين؟ على سبيل المثال: هل يمكن أن تكتمل قصة النمور الآسيوية والمعجزة الآسيوية أو قصة تخلُّف إفريقيا بدون الحرب الباردة؟ يحاول Fwatshak في هذا الفصل الإجابة عن هذه الأسئلة، وغيرها.
في نهاية الحرب الباردة، اقتصادات إفريقيا وآسيا كانت مختلفة بشكلٍ ملحوظ. كانت إفريقيا لا تزال قارة فقيرة ومتخلفة وفاشلة وغير مُنتِجَة. اكتسبت ثماني دول في آسيا سمعة دولية باسم “النمور” أو كان الاقتصادات الآسيوية (HPAEs) عالية الأداء؛ لكونها أكثر ثراء وتقدُّمًا ونامية. شكَّل هذا الوضع في الواقع لُغزًا لعدة أسباب:
أولًا: عند الاستقلال في الستينيات، اعتقد المتفائلون الأفارقة، بما في ذلك القوى الغربية، أنه بفضل مواردها الطبيعية الهائلة، ستتطور إفريقيا بشكل أسرع من آسيا. كان من المتوقع أن تصل إمكانات النمو في إفريقيا إلى 7% سنويًّا. جادل المتفائلون بأن إفريقيا لم تكن جزءًا من العالم الفقير الذي وصفه اقتصاديو الخمسينيات بأنه عالم مزَّقته “الحلقة المفرغة للفقر” و”الفجوة الآخِذة في الاتساع” بين الدول الفقيرة والعالم الصناعي الغنيّ. لم يتحقق أيّ من ذلك.
ثانيًا: تاريخيًّا، تقاسمت إفريقيا وآسيا مصيرًا مشتركًا يتمثل في الاستعباد والاستغلال الاستعماري والتخلف على يد القوى الأجنبية. ولم تنجُ من الاستعمار الرسمي سوى دولة واحدة في كلٍّ من المنطقتين، هما إثيوبيا وتايلاند على التوالي؛ وكان تحرُّرهما من الحكم الاستعماري قد حدث بعد الحرب العالمية الثانية، وكان هذا يوحي بمصير مشترك، إلا أن ذلك لم يكن ليحدث.
ثالثًا: حتى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، كانت دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعديد من الدول في آسيا على نفس المستوى الاقتصادي تقريبًا. كانت دولًا تعتمد على الموارد الطبيعية والمعونة؛ وكانت زراعية في الغالب وليست صناعية، كما هو الحال في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا وكوريا الجنوبية (في الستينيات) وماليزيا (في السبعينيات). كان العديد منها من بين أقل البلدان نموًّا ومثقلة بالديون والفقيرة في العالم.
تميزت الحرب الباردة بالمنافسة العدائية على الهيمنة العالمية في الفلسفة الاقتصادية والسياسية وممارسة إدارة الدولة، وكانت الأطراف الرئيسية في الحرب الباردة هي الولايات المتحدة الرأسمالية وحلفاؤها في أوروبا الغربية من جهة، والاتحاد السوفييتي وحلفاؤه من جهة أخرى.
اعتمد مبدأ السياسة الخارجية للاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة وسياسته الخارجية بشكل عام؛ على تدويل البروليتاريا والتعايش السلمي مع الدول غير الاشتراكية. وجرى تعزيز التعاون داخل الدول الاشتراكية وفيما بينها من خلال مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة (CMEA). بينما تمثلت السياسة الرئيسية للولايات المتحدة في إفريقيا خلال الحرب الباردة في منع الاتحاد السوفييتي من اكتساب نفوذ مهمّ خارج أوروبا الشرقية. وهكذا، أجبر اختراق الاتحاد السوفييتي وكوبا لأنغولا وإثيوبيا في سبعينيات القرن الماضي الولايات المتحدة على التركيز على إفريقيا، مما أدَّى إلى تفاقم التنافس بين القوتين العظميين.
دفع تنافس القوى العظمى على الهيمنة العالمية الولايات المتحدة إلى وضع وتطبيق سياسات وممارسات مفيدة لآسيا؛ إذ لم تدَّعِ آسيا الحياد، بل وقفت إلى جانب الولايات المتحدة. إلا أن سياسات وممارسات الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي تجاه إفريقيا، وما يسمى بعدم الانحياز في إفريقيا، لم تُسْفِر عن النتيجة نفسها؛ وبالتالي، برزت اختلافات. كانت الحرب الباردة مسؤولة إلى حدّ كبير عن هذه الاختلافات الاقتصادية؛ إذ هيَّأت بيئة مواتية لتنمية آسيا وأخرى غير مواتية لإفريقيا. وللعامل البيئي أبعاد متعددة، أبرزها سياسات وممارسات الحرب الباردة التي انتهجتها كلّ من القوتين العظميين في المنطقتين.
كما هيَّأت الحرب الباردة بيئة اقتصادية مُواتية بطرق عدة؛ فقدمت الولايات المتحدة، ضمان الأمن والوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا؛ وشاركت أوروبا الغربية في تقديم المساعدات والتنمية. خلال الحرب الباردة، قدمت الولايات المتحدة خدمات جليلة لدول حوض المحيط الهادئ، بما فيها الدول الآسيوية، مما جعل البيئة الاقتصادية في المنطقة مُواتية للتنمية. وبعد إبرام اتفاقيات متبادلة مع هذه الدول، وضعت الولايات المتحدة ونفَّذت سياسات داعمة للنمو لصالحها. ساعد الأمن الذي وفَّرته الولايات المتحدة المنطقة على التركيز على الأداء الاقتصادي، مع الاستفادة من التكنولوجيا الأمريكية “ذات الاستخدام المزدوج”، أي التكنولوجيا المستخدَمة في القطاعين المدني والعسكري. وهكذا، بفضل هذا السلام والهدوء، بدأت العديد من الدول الآسيوية المستفيدة تحقيق قفزة نوعية في النمو الاقتصادي والتنمية. وتمتعت الدول الآسيوية المشمولة بالاتفاق الخاص بإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والأسواق الأمريكية خلال الحرب الباردة. أما إفريقيا فلم تحظَ بمثلِ هذه الفرص، وحيثما حظيت بها، كما هو الحال مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية، لم تمنح سوى وصول محدود إلى الأسواق. خلال الحرب الباردة، تلقَّت آسيا مساعدات اقتصادية ومساعدات من الغرب أكثر مما تلقته إفريقيا، وقد أثمرت هذه المساعدات عن نتائج إيجابية.
على النقيض مما حدث في آسيا، خلقت الحرب الباردة بيئة اقتصادية غير مواتية في إفريقيا. فلم تُبْرِم الدول الإفريقية اتفاقًا مماثلًا مع أيٍّ من الطرفين الرئيسيين خلال الحرب الباردة. ولذلك، لم تحظَ بأيِّ فوائد. بل غرقت في مشكلات متنوعة أعاقت النمو الاقتصادي والتنمية. تُجسِّد ثلاثة مجالات رئيسية هذه المشكلات: انعدام الأمن الناجم عن الحروب الداخلية، ونقص الفرص الاقتصادية والسياسية. فكان للتحديات الأمنية في إفريقيا خلال الحرب الباردة أبعاد عديدة. أولًا، كانت إفريقيا مسرحًا للحرب؛ إذ استخدمت لخوض حروب بالوكالة. وهكذا، تورطت إفريقيا في صراعات داخلية شملت مؤيدين لأحد طرفي الصراع الرئيسيين في الحرب الباردة خلال نضالها من أجل الاستقلال وبعده. ساهم التدخل العسكري للاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في إفريقيا في دعم الحروب هناك وتشجيعها، مما أدَّى إلى خسارة عائدات نقل الأسلحة، وانعدام الأمن العام، ودمار في الأرواح والممتلكات، ونقص في الغذاء، بالإضافة إلى تخلُّف عام في القارة.
من القضايا الأخرى المتعلقة بنقص الفرص الاقتصادية، التنافس الثنائي على إفريقيا؛ حيث تنافست القوى الغربية والروسية على موارد إفريقيا. واستغل المتنافسون الحرب الباردة لتحقيق مصالحهم الاقتصادية والإستراتيجية في إفريقيا. وبينما هيمن الترويج للأيديولوجيا على مصالحهم في آسيا، شكَّل الاستغلال الاقتصادي والمزايا الإستراتيجية اعتباراتهم الرئيسية في إفريقيا، وخاصة من جانب الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. كان لكل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي مصالح اقتصادية وإستراتيجية في إفريقيا، لا سيما استغلال موارد القارة في ظل التنافس مع القوى الاستعمارية السابقة.
كانت السياسة، -وهي الفئة الثالثة من قضايا مناهضة التنمية في إفريقيا خلال الحرب الباردة- تُشكّل مجالات واسعة من القضايا التي اتسمت بأبعاد مختلفة. فعلى الرغم من أن الحتمية الاقتصادية تنص على أن البنية الاقتصادية تُحدِّد هياكل المجتمع الأخرى، إلا أن سياسات الحرب الباردة في إفريقيا ما بعد الاستعمار أثبتت عكس ذلك. فقد حددت السلطة السياسية البنية الاقتصادية التي يجب تبنّيها. وأدّى الحكم الفردي إلى سياسات اقتصادية متضاربة؛ حيث سادت الانقلابات العسكرية. وقد أثَّرت السياسة سلبًا على الاقتصادات الإفريقية بثلاث طرق رئيسية: الديكتاتوريات الوحشية، والانقسام/الاضطراب الأيديولوجي، وتناقضات سياسات الاتحاد السوفييتي، وفشل حركة عدم الانحياز. وبشكلٍ عام، أدَّت الحرب الباردة في إفريقيا وآسيا إلى خنق نموّ الديمقراطية؛ لأنها دعمت الديكتاتوريات غير الديمقراطية أو العسكرية أو ذات الحزب الواحد والتي أضرَّت بتقدم الدولة. ودعمت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي الحكام الدكتاتوريين في إفريقيا وآسيا.
تسببت الحرب الباردة أيضًا في انقسامات أيديولوجية حادة في القارة الإفريقية. تجلى ذلك في الارتباك بين القادة الأفارقة والعمال والشباب والمنظمات الطلابية حول أيٍّ من هذه الأيديولوجية التي يجب اعتمادها في الإدارة السياسية والاقتصادية للدول والاتحادات. بينما قاومت بعض الدول الإفريقية؛ -مثل: كينيا وساحل العاج ونيجيريا وليبيريا- الشيوعية، اتجهت دول أخرى نحو الاشتراكية.
خلاصة الفصل: في الواقع، قدَّمت الولايات المتحدة تضحيات اقتصادية جسيمة للدول الآسيوية المستفيدة. كما تمتعت الدول الآسيوية بمزيد من المساعدات والرعاية من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية في توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر. من ناحية أخرى، عانت إفريقيا من بيئة اجتماعية وسياسية واقتصادية منهكة.
الفصل السادس:
بعنوان “عبء ديون إفريقيا ومبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون: الكاميرون، من التحديات إلى الفرص”. بواسطة: أوغسطين إي. أيوك Augustine E. Ayuk
بعض المشكلات التي ابتُليت بها القارة الإفريقية في فترة ما بعد الاستقلال/ما بعد الاستعمار، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المجاعة والجفاف، والصراعات العرقية والإقليمية، والحكم الاستبدادي، وسوء الإدارة، واختلاس الأموال الحكومية، والفساد. ويُعتقد أن هذه المشكلات قد تفاقمت بسبب انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الذي اجتاح العديد من البلدان في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
كما يشير إلى أن أزمة الديون ربما كان لها أكبر الأثر على النفسية السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية لإفريقيا اليوم. علاوةً على ذلك، يمكن أن يمنع عبء الديون الخارجية العديد من البلدان في القارة من تحقيق أهدافها الإنمائية للألفية أو بلوغها بحلول عام 2015م. وقد أقنعت شدة أزمة الديون الدائنين متعدّدي الأطراف والثنائيين (المؤسسات المالية الدولية) والحكومات في البلدان الصناعية باقتراح وتنفيذ تدابير لتحسين اقتصادات القارة المتداعية ومشكلات الديون. يُكرِّس “أيوك” فصله بالكامل تقريبًا لدراسة وشرح نشأة وأبعاد مشكلات الديون الخارجية في إفريقيا، بالإضافة إلى مناقشة الآليات المختلفة التي اقترحها الدائنون متعددو الأطراف والثنائيون لمعالجة عبء الديون. ويستعرض الفصل الكاميرون كدراسة حالة، ويُقدّم تقييمًا لأداء هذه الدولة في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (EHIPC).
المجاعة، والجفاف، والصراعات العرقية والإقليمية، والحكم الاستبدادي، وسوء الإدارة، واختلاس الأموال العامة، والفساد، ليست سوى أمثلة قليلة على المشكلات التي ابتُلِيَت بها قارة إفريقيا في فترة ما بعد الاستقلال/ما بعد الاستعمار. وقد تفاقمت هذه المشكلات بسبب انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الذي عصف بالعديد من دول القارة، وخاصة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى. وإلى جانب الإيدز، ربما كان لأزمة الديون المفرطة في إفريقيا أكبر الأثر على الحالة السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية لإفريقيا اليوم.
يناقش الفصل نشأة مشكلات الديون الخارجية في إفريقيا وأبعادها وخصائصها، كما سيناقش الآليات المختلفة التي اقترحها الدائنون متعددو الأطراف والثنائيون لمعالجة معضلة تراكم الديون في القارة. وبالمثل، سيتناول الفصل الحجج المؤيدة والمعارضة لإلغاء ديون الدول الإفريقية وغيرها من الدول النامية. وسيركز بشكل خاص على الكاميرون، ومعاناتها مع عبء الديون الخارجية، والخطوات المتخذة لتخليصها من فخّ الديون. وسيختتم الفصل بتقييم لأداء الكاميرون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (EHIPC).
يطرح الفصل سببين لديون القارة؛ يُركِّز المنظور الأول على العوامل الداخلية أو الداخلية، بينما يُركِّز المنظور الثاني على العوامل الخارجية أو الخارجية. تُلْقِي الأنظمة الغربية والدائنون باللوم في ديون إفريقيا المفرطة على قوى داخلية، بما في ذلك سوء الإدارة، والقادة السياسيين الجشعين والفاسدين، والصراعات الأهلية طويلة الأمد، وغياب الضوابط والتوازنات الديمقراطية على الاقتراض والإنفاق الحكومي، والنمو السكاني غير المتحكَّم فيه، والسعي وراء سياسات اقتصادية تهدف إلى إثراء النُّخَب على حساب الجماهير.
كان لأزمة الديون وما نتج عنها من أعباء على إفريقيا قوة دافعة ذاتية. فالموارد التي كان من الممكن استخدامها لبناء المدارس والمستشفيات وتشييد الطرق الرابطة بين المزارع والأسواق تُحوّل الآن لخدمة الديون المستحقة للدول الصناعية. ونتيجة لذلك، سيقل عدد الأطفال الذين سيعيشون حتى بلوغهم عامهم الأول، وسيُواجه مَن يبقون على قيد الحياة فرصًا أقل وظروفًا صعبة. ومن التكاليف الرئيسية الأخرى لأزمة الديون، المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بتدهور مستويات المعيشة في إفريقيا: تزايد حوادث العنف السياسي.
الكاميرون: من التحديات إلى الفرص:
بعدما يقرب من عقدين من النمو الاقتصادي القوي والمستدام، تم تقديم اقتصاد الكاميرون كنموذج يجب أن تحتذي به البلدان الأخرى في إفريقيا. على الرغم من ضآلة تأثير الكاميرون على الاقتصاد العالمي إقليميًّا، إلا أنها تعتبر قوة اقتصادية مؤثرة في المنطقة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا. بصفتها قوة اقتصادية إقليمية مهيمنة، تمثل الكاميرون أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لدول وسط إفريقيا، وتُمثّل سوقًا رئيسية وبوابة رئيسية للدول غير الساحلية مثل تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى. بعد الاستقلال، اعتمدت الكاميرون سياسات تجارية وقائية تهدف إلى حماية الصناعات الناشئة وتشجيع التنمية الصناعية. ولتحقيق هذه الأهداف، استخدمت البلاد آليات وأدوات متنوعة، بما في ذلك الضرائب الانتقائية، والإعفاءات الضريبية، وضوابط الأسعار، والحواجز الجمركية، وقيود الاستيراد.
شهدت الكاميرون العديد من التحديات الهائلة التي أعاقت المزيد من النمو في الاقتصاد. وشملت هذه التحديات استمرار انخفاض أسعار السلع الأساسية بسبب دخول منافسين جدد إلى السوق (موردين من جنوب شرق آسيا). واستخدم المنافسون الجدد تقنيات أكثر تقدمًا مقارنة بالمزارعين في الكاميرون. وكان ردّ الفعل الأوّلي من جانب المسؤولين الحكوميين هو ترك أسعار المنتجين دون تغيير بينما استوعبت الحكومة الخسائر التي تكبَّدتها هيئة التسويق من خلال الميزانية؛ انخفاض إنتاج النفط؛ ارتفاع سعر الصرف الحقيقي؛ عملة مبالغ في قيمتها؛ انقلاب عسكري فاشل؛ انزلاقات في السياسات؛ نمو سكاني سريع (بمعدل ٣٪ سنويًّا)؛ انخفاض قيمة الفرنك الإفريقي في عام ١٩٩٤م، تدهور شروط التبادل التجاري.
خلاصة الفصل: شلَّت أزمة الديون معظم الدول النامية في العالم، ولا سيما دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. تجاوزت الأزمة الحدود السياسية، وكان تأثيرها واسع النطاق. لم تتسبَّب أزمة الديون في تخلُّف إفريقيا عن مناطق العالم الأخرى في النمو الاقتصادي والتنمية البشرية فحسب، بل ساهمت أيضًا في تفاقم عدم المساواة داخل هذه الدول.
الفصل السابع:
تأثير حجم الأسرة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الكاميرون: تحليل نقدي. بواسطة: كونسولر تيبوه Consoler Teboh
لقد تم إعطاء الكثير من الاهتمام لعدد وتنوُّع وقوة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تُؤثّر على النساء وتدفعهن إلى تحديد النسل عمدًا، وبالتالي الحدّ من حَجْم أُسَرهن. وكان هذا هو الاتجاه السائد في معظم البلدان الغربية، وتُظْهِر الأبحاث أن بعض البلدان الإفريقية والشرق الأوسط بدأت أيضًا تشهد انخفاضات طفيفة في النمو السكاني.
الكاميرون من بين دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي شهدت انخفاضًا تدريجيًّا في معدل الخصوبة. وتحديدًا، خلال العقدين الماضيين، انخفض معدل الخصوبة في البلاد بنسبة 2.71% في عام 1991م، بلغ معدل الخصوبة 6.8% وحاليًّا هو 4.09%. يمكن أن يُعزَى هذا التراجع إلى الاتجاهات المعروفة باسم المبتكرين الديموغرافيين، التي تُؤثِّر على حجم الأسرة.
يطرح الفصل الأسباب المتعددة التي تؤثر على حجم الأسرة؛ كوسائل تنظيم الأسرة؛ ومكان الإقامة؛ والوضع الاجتماعي والاقتصادي؛ الأُطُر السياقية والنظرية؛ هناك أدلة كافية تشير إلى أن نجاح الجهود الرامية إلى خفض معدلات المواليد سوف يعتمد على تحسين وضع المرأة.
خلاصة الفصل: يدرس كونسولر تيبوه السمات الديموغرافية التي تؤثر على حجم الأسرة في محاولة لتحديد ما إذا كانت المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية تُحسِّن نوعية حياة النساء في الكاميرون. استخلصت بيانات هذا الفصل من المسح الديموغرافي والصحي لعام 2004م (DHS-III). أُجْرِي المسح من فبراير إلى أغسطس 2004م، وشمل 10.462 أسرة، أو 10.656 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15- 49 عامًا. استخدم التحليل أحادي المتغير واختبارات مربع كاي لتحديد النتائج. وجد “تيبوه” أنه على عكس المملكة المتحدة واليمن ونيجيريا، لم يؤثر سنّ الزواج على حجم الأسرة في الكاميرون، ولكنّ جميع المؤشرات الأخرى أثَّرت. كما أشار الفصل إلى أن بعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لم تُحَسِّن نوعية حياة النساء الكاميرونيات.
الفصل الثامن:
بعنوان سياسات الثقافة في مجتمع الزولو في جنوب إفريقيا المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التجربة: آثارها على خطاب ما بعد الفصل العنصري. بواسطة: أوستن سي. أوكيجبو Austin C. Okigbo
يتناول أوستن أوكيجبو جدلًا حول الطبول شهده في مستشفى ماكورد McCord في Durban ديربان، جنوب إفريقيا. نشأ هذا الجدل مِن رفض إدارة المستشفى البيضاء استخدام طبول الزولو مِن قِبَل سيفيثيمبا جوقة Siphithemba Choir. (وهي جماعة دعم لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تحوَّلت إلى فرقة كورالية)؛ إلا أن جدل الطبول سلَّط الضوء على قضايا أخرى. وقد نشأت بالفعل خلافات بين الجوقة وإدارة المستشفى؛ كان النزاع حول طبل الزولو المثال الأول. يجادل أوكيجبو بأن هذا الجدل يشير إلى استمرار سياسات الثقافة والهوية، التي كانت جزءًا لا يتجزأ من نظام الفصل العنصري، والتي أُعِيد إنتاجها وتكرارها في سياق التجربة الحالية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ماذا يعني إذن أن يصبح الأداء الموسيقي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مساحة تنخرط فيها الجهات المتعارضة سابقًا في نظام الفصل العنصري في نزاع ثقافي؟ باستخدام هذا الحدث الموسيقي الفريد، يُحلّل أوكيجبو ديناميكيات العلاقات الثقافية بين الأعراق في جنوب إفريقيا، كما يتساءل عن مفهوم “ما بعد الفصل العنصري” كخطاب.
في جنوب إفريقيا، تم التعرُّف على تاريخ نظام الفصل العنصري وآثاره المستمرة مِن قِبَل علماء الصحة العامة والطب الاجتماعي أن يكون لها تأثير خطير على التجربة الحالية لجائحة فيروس نقص المناعة البشرية. ولمواءمة الجدل حول استخدام الطبل كسياسة ثقافية مع خطاب “ما بعد الفصل العنصري”، لا يمكن سَرْد قصة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في جنوب إفريقيا، ولا يمكن استيعاب الصورة الكاملة، إلا أن قصة الفصل العنصري تُشكِّل جزءًا من الخلفية التي يرسم عليها السرد. وفي ضوء ذلك، يجب أن نضع في اعتبارنا أن الفصل العنصري كان أيديولوجية ذات تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. لغرض هذا الفصل، يتم تناول مسألة الفصل العنصري كسياسة ثقافية.
تأثر نظام الفصل العنصري بالمشاريع التبشيرية الاستعمارية، التي شوَّهَت الثقافات الإفريقية، وفي كثير من الأحيان حرّمت العديد من المصطلحات الثقافية الإفريقية. وبمجرد ترسيخ هذه الأفكار التبشيرية حول الثقافة الإفريقية وثقافة الزولو، أصبحت أُسسًا لصياغة المكونات الثقافية للسياسات العرقية للاتحاد منذ القرن التاسع عشر، وبلغت ذروتها في إضفاء الطابع المؤسسي على نظام الفصل العنصري كسياسة دولة بين عامي 1948، 1990م.
الذين يُحلّلون آفاق التنمية المستقبلية على خلفية إرث الفصل العنصري. وبينما ركَّز الخطاب بشكل كبير على القضايا المتعلقة بالسياسة والتنمية الاقتصادية، فإن الظروف الثقافية للفصل العنصري لم تُحَلّ بعدُ، ونادرًا ما عُولِجَت كحلٍّ ناجع للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة. فقد ركَّز خطاب ما بعد الفصل العنصري بشكل كبير على قضايا التنمية السياسية والاقتصادية وحقوق الإنسان في جنوب إفريقيا. ونادرًا ما اهتم الخطاب بالدين والثقافة، اللذين كانا حجر الزاوية الرئيسي في الصياغة الأولية لسياسة الفصل العنصري. حتى فشلت لجنة الحقيقة والمصالحة (TRC) في معالجة قضية الانتهاكات الثقافية التي وُجِّهت إليها.
الفصل التاسع:
صراع الأرض والصراع في الوادي المتصدّع في كينيا: التاريخي والمعاصر وجهات نظر. بواسطة: مارتن شانغويا Martin Shanguhyia وميكي موانزيا كوستر Mickie Mwanzia Koster
يُعزّز الفصل فهمنا للتطور التاريخي للطبيعة الافتراضية لسياسات وعلاقات الأراضي من الحقبة الاستعمارية إلى حقبة ما بعد الاستعمار، والتناقضات الكامنة في تلك السياسات والعلاقات، ومدى تأثيرها في إثارة التوترات والصراعات على الأرض منذ أواخر القرن التاسع عشر. لا يُركّز الفصل فقط على أسباب هذه الصراعات، بل يُركّز أيضًا على كيفية استخدام الدولة والمجتمعات المختلفة للأرض لحماية مصالحها على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية. ويجادل بأنه منذ بداية الاستعمار، سعت مجتمعات وحركات مختلفة إلى الاستيلاء على الأراضي في وادي الصدع من خلال طرح العديد من المعاني والحجج العرقية والاقتصادية والسياسية والإثنية والروحية، بطرقٍ أدَّت إلى استياء وتوترات وصراعات صريحة بين المجتمعات في المقاطعة. كما يوضّح أن الصراع الذي أدَّى إلى الخوف وإراقة الدماء وفقدان الأرواح كان نتيجة التزام بعض المجتمعات والحركات بمعالجة أوجه القصور في علاقات الأراضي في كينيا. وبالتالي، استهدفت هذه المجتمعات والحركات الدولة وحلفاءها، معتبرة إياهم يُعزّزون أجندة مثيرة للجدل في علاقات الأراضي، قوَّضت الرفاه الثقافي والاقتصادي والاجتماعي لغالبية سكان الريف المعتمدين على هذا المورد.
تساهم الدراسة في تأريخ أراضي كينيا من خلال إطالة معالجة كينيا باعتبارها “واديًا تعيسًا” مع استخدام منطقة جغرافية مهمة تاريخيًّا -وادي الصدع-، لفهم الاتجاهات في التاريخ السياسي والاجتماعي لكينيا الحديثة.
خلقت سياسات الأراضي الاستعمارية نمطًا افتراضيًّا لعلاقات الأراضي، مما همَّش المجتمعات الإفريقية المحلية وأنماط إنتاجها من خلال تقييد وصولها إلى أهم مورد في هذه العمليات، ألا وهو الأرض. ومع تشديده على الإقصاء، وَلَّد هذا النمط الاستعماري تناقضات في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مما وَلَّد بدَوْره صراعات ومواجهات دامية على الأرض بين الحكومة والمجتمعات المحلية في كينيا. فبعد إنهاء الاستعمار في المرتفعات البيضاء السابقة في ستينيات القرن الماضي، ظلت الأجزاء الزراعية المنتجة في وادي الصدع المتصدع في كينيا ساحة للتنافس على حقوق الأراضي والهوية العرقية وإمكانية الوصول إلى السياسة الوطنية. لقد احتلت الأرض مكانة مركزية في هذه المنطقة لدرجة أنها ظلت المنطقة الأكثر “تسييسًا” في كينيا، كما تشهد دورات العنف السياسي التي اجتاحت المقاطعة في كل دورة انتخابية منذ أواخر الثمانينيات.
يضم وادي الصدع الكبير مشهدًا جغرافيًّا مهيبًا يشقّ كينيا من الحدود الإثيوبية شمالًا إلى الحدود التنزانية جنوبًا. يهيمن هذا المنخفض الشاسع على الأجزاء الوسطى والغربية من البلاد، وهو موطن للعديد من المجتمعات التي تعتمد على زراعة الأراضي والرعي. يُشكّل إقليم وادي الصدع المتصدع معظم أراضيه، مما يجعله أكبر الوحدات الإدارية الإقليمية الثماني في كينيا. تشتهر الأجزاء الوسطى من وادي الصدع تحديدًا بأراضيها الخصبة الشاسعة ومراعيها الوارفة. إلا أن قدرتها الزراعية هي التي ميَّزت مكانتها كمخزن حبوب كينيا منذ الحقبة الاستعمارية. وقد أدت هذه القيمة الاقتصادية للمنطقة إلى مخططات واسعة النطاق لتوزيع الأراضي لصالح الاستيطان الأوروبي مِن قِبَل الدولة الاستعمارية البريطانية في مطلع القرن العشرين، مما أدَّى إلى تحويل مرتفعات وادي الصدع الوسطى إلى جزء من “المرتفعات البيضاء”.
إنّ محاولة فهم الأساس الرأسمالي الذي بني عليه الاستيطان الأوروبي في كينيا تسهم في تشكيل فهمنا لكيفية تطور العلاقات المتوترة حول الأرض بين الدولة الاستعمارية والمجتمعات الإفريقية في وادي الصدع والمناطق المحيطة به. استند الاقتصاد الزراعي الذي تصوّره المسؤولون الاستعماريون الأوائل إلى افتراض أن المزارع الزراعية واسعة النطاق التي تديرها مزارع أوروبية “متقدمة” هي السبيل الأكثر فعالية لدمج الدولة المحتلة في الاقتصاد العالمي. واعتبرت أنماط الإنتاج الزراعي والرعوي الإفريقية غير كافية لتلبية احتياجات “الاقتصاد الحديث” المتوخى للنظام العالمي الذي أدخلت فيه كينيا ومجتمعاتها الإفريقية. وصف المفوض البريطاني بأنهم “غير منتجين”، ويجب طردهم من حقول الرعي “الأصلية”. أصبح هذا التفكير أساسًا لاستهداف الأراضي الإفريقية للتهجير بهدف بناء مستوطنة أوروبية في كينيا مع مطلع القرن العشرين.
أدى الاستيلاء على الأراضي إلى إنشاء محميات إفريقية تم حصر العديد من المجتمعات التي فقدت أراضيها فيها، وعاشت حياة كريمة. تم ترسيم الحدود لفصل هذه المحميات عن الأراضي المخصصة للاستيطان الأوروبي، وفصل المجتمعات العرقية المختلفة التي تم تخصيصها لمحمياتها. كان الهدف من إنشاء المحميات عزل الأراضي المخصصة عن تسلل المجتمعات الإفريقية المهجورة، والعمل كمستودعات للعمالة للمؤسسات الأوروبية.
تظهر انتفاضة الماو ماو كيف تبلورت العلاقات المتعلقة بالأرض في كينيا في ساحة مشجّعة بالصراع. يبرز العنف وما صاحبه من جرائم قتل وتدمير، والتي اتسم بها طرفا الصراع، الوسائل التي سعى كلّ منهما من خلالها إلى تحديد مصالحه. تجاوزت الحكومة الاستعمارية سياساتها المتعلقة بالأرض وغيرها، والتي دفعت الكيكويو وغيرهم من الأفارقة إلى هامش الفقر واليأس، ونزعت الشرعية عن الانتفاضة بإطلاق العنان للأسلحة الثقيلة للقوات الاستعمارية، والتي خلَّفت خسائر بشرية فادحة لم يشهدها تاريخ كينيا آنذاك. نشأت هذه الحركة التي يهيمن عليها الكيكويو في وادي الصدع الأوسط في أواخر أربعينيات القرن العشرين، وكانت تهدف إلى طرد جميع الأوروبيين من كينيا وتنصيب الأفارقة “حكامًا للأرض”.
الفصل العاشر:
هجرة المهنيين من إفريقيا: تقييم تأثير “هجرة الأدمغة” من القارة. بواسطة: جي كيه مابولانجا-هولستون J. K. Mapulanga-Hulston
يدرس الفصل أثر الارتفاع المستمر في هجرة المهنيين ذوي الكفاءات العالية من إفريقيا، والمعروفة أيضًا باسم “هجرة الأدمغة”. وتشير مابولانجا-هولستون إلى أن هذه الهجرة لا تزال تبطئ التنمية الاقتصادية في القارة. كما يتناول الفصل الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والشخصية وراء هذه الهجرة. ويجادل المؤلف، على وجه الخصوص، بأن هجرة أدمغة المهنيين الصحيين تمثل مشكلة رئيسية ذات عواقب وخيمة على القارة. ويختتم الفصل ببعض الخيارات السياسية والتوصيات الرامية إلى معالجة هذا التوجه الحالي.
تُعدّ أسباب الهجرة الأكثر شيوعًا هي التفاوت في مستويات الدخل، وارتفاع البطالة، ونقص الرعاية الاجتماعية الكافية. في حين أن العولمة، وتحرير التجارة، وآليات الاقتصاد العالمي قد أدَّت إلى زيادة العرض الفعلي للعمالة الماهرة عبر الحدود الدولية، فإن هجرة المهنيين الأفارقة المهرة إلى الغرب، وتحديدًا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، قد تكون لها آثار مدمرة. وهذا يجعل موضوع الهجرة الدولية قضية سياسية وبحثية رئيسية على المستويين الوطني والإقليمي. يُقدّم هذا الفصل لمحة عامة عن تأثير هجرة الأدمغة الإفريقية من خلال معالجة أسبابها وتداعياتها على القارة. ويركز بشكل خاص على هجرة أدمغة العاملين في مجال الصحة.
الأسباب الرئيسية للهجرة الجماعية من إفريقيا مالية أو اقتصادية في الغالب، ولكنّها قد تكون أيضًا اجتماعية أو سياسية؛ حيث إن تدهور البيئة السياسية والاجتماعية في بلدان المنشأ يُعدّ متغيرًا مهمًّا في الهجرة. وتلعب الهجرة الاقتصادية دورًا في الحد من نقص المهارات في البلدان المستقبِلة، وبالتالي التأثير على أوضاعها المالية، فإن المنطقة الإفريقية تخسر فرص النمو والتنمية من خلال الخسارة الجماعية لقاعدة معارف أعداد كبيرة من المهاجرين. وقد وجدت دراسة علمية أن جنوب إفريقيا تعاني من نقص خطير في العمالة الماهرة، مما كان له تأثير سلبي على الآفاق الاقتصادية للبلاد والنمو والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومِن ثَمَّ، فإن هجرة المهنيين المهرة تؤدي إلى عواقب اقتصادية ضخمة من حيث الخسائر في المالية العامة.
للهجرة أيضًا آثار اجتماعية مهمة في كل من البلدان المستقبِلة والمُصدّرة؛ لأنها جزء من عملية التغيير الاجتماعي. لا تقتصر هذه العملية على ترك الشبكات الاجتماعية، بل قد تشمل أيضًا تجارب الشعور بالفقدان والتشرد والاغتراب والعزلة؛ حيث إن الهجرة تنطوي بالأساس على آلية داخلية تهدف إلى الحد من مواطن الضعف المرتبطة بالتفاوتات الكامنة، ولكنها تنطوي أيضًا على انقطاع الاتصال الجسدي بأفراد الأسرة، مما يؤدي إلى “سمة دائمة من الضعف في تواصلهم مع الأصول”.
تأثير هجرة الكوادر الإفريقية:
إن السبب الرئيسي لهجرة المتخصصين في مجال الصحة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة هو الأجور المرتفعة وظروف العمل الجيدة؛ حيث تعاني أنظمة الرعاية الصحية في القارة من نقص في البنية التحتية والموارد، وتكافح جاهدةً لتوفير رعاية صحية كافية للجميع. وقد أدَّى الانخفاض الحادّ في أعداد الكوادر الصحية، نتيجة لهجرة الكوادر، إلى نقص في الموارد البشرية في قطاع الصحة، مما حدَّ من قدرته على توفير الرعاية الصحية اللازمة. وقد نتج عن ذلك عواقب وخيمة على القارة في مجال الرعاية الصحية. وتتأثر إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشكل خاص بالهجرة الجماعية.
ومن أجل الحدّ من هجرة الكوادر الطبية؛ يجب على القادة الأفارقة البحث عن سُبل عملية للاحتفاظ بالكوادر الصحية وتوظيفها. وهذا يتطلب دراسة ومعالجة نقاط الضعف النظامية، مثل نقص الأموال والموارد، وممارسات إدارة قطاع الصحة غير الفعّالة. قد تساعد هذه الخطوة في تعزيز وتوفير بيئات عمل مناسبة وملائمة. قد تحتاج القارة إلى “إطلاق حملة تثقيفية وتوظيفية عاجلة وواسعة النطاق في قطاع الصحة”، والأهم من ذلك، ضرورة التزام القادة الأفارقة بالاستثمار في قطاع الصحة والشروع في إصلاح صحي فعَّال. ويجب أن يتبع هذا الالتزام إعادة تنظيم أو إعادة ترتيب أولويات الميزانيات الحكومية.
خلاصة الفصل: تؤثر هجرة العقول على تنمية إفريقيا على المستويات الفردية والوطنية والإقليمية. ويواجه القادة الأفارقة عددًا من التحديات في تعزيز التنمية في بلدانهم. في حين أن هناك اعترافًا بأن الهجرة الدولية ليست السبب الوحيد للمشكلات التي نواجهها، فإن الجدل هو أنها تُشكّل عاملًا رئيسيًّا إن لم يكن الأكثر تفاقمًا وهو عامل خطير بما يكفي ليتطلب حلولًا عملية عاجلة.
الفصل الحادي عشر:
وهو الفصل الختامي بعنوان الخلاصة: إفريقيا التي تعمل. بواسطة: تويين فالولا وإيمانويل إم مباه Toyin Falola and Emmanuel M. Mbah
والذي يجادل بأنه على الرغم من التفاؤل الجديد بشأن النمو الاقتصادي والتحسينات الاجتماعية، فإن القارة لا تزال تواجه العديد من التحديات في النمو الاقتصادي، والفقر، والرعاية الصحية، وتغير المناخ، وقضايا النوع الاجتماعي، والشفافية السياسية، والمساءلة، وإشراك المواطنين في صنع القرار. بدأت القارة تُحْرِز تقدُّمًا نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب إنجازه. وهكذا، فبينما لا تزال معدلات الفقر في إفريقيا أعلى مقارنة بمناطق أخرى من العالم، انخفضت المعدلات بشكل ملحوظ بين عامي 1990، 2008م، ولم يقطعها سوى الأزمة الاقتصادية العالمية، وما نتج عنها من نقص غذائي ضرب القارة. لذلك، شهدت الفترة بين عامي 1990، 2008م مكاسب اجتماعية واقتصادية نسبية، كما سجَّلها تقرير الأمم المتحدة للأهداف الإنمائية للألفية لعام 2009م.
يرى المؤلف أنه على الرغم من التفاؤل الجديد بالنمو الاقتصادي والتحسينات الاجتماعية، لا تزال القارة تُواجه تحديات عديدة. لذلك على إفريقيا الفعَّالة أن تضمن وصول النمو والازدهار إلى الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. لذا، على القادة السياسيين والاقتصاديين معالجة مسألة العولمة والمعاملات العالمية للحدّ من آثارها السلبية على الفقراء. صحيح أن الدول القومية في إفريقيا تفتقر إلى رأس المال الاقتصادي والسياسي أو النفوذ اللازم للتأثير على المعاملات العالمية، إلا أنها تستطيع تحقيق مكاسب من خلال التفاوض “بشكل جماعي لصياغة أنظمة تجارية واستثمارية عالمية تلبي احتياجاتها”، لا سيما وأن التفاوض الجماعي من خلال التكامل الإقليمي “يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة في التجارة والاستثمار، مما يُعزّز النمو الشامل والتنمية البشرية”.
لا تزال معالجة التحديات البيئية، وخاصة تغيُّر المناخ، تُمثّل مشكلة خطيرة للقارة. وتمثل إزالة الغابات إحدى العقبات الرئيسية؛ حيث فقدت 4.1% من غابات إفريقيا بين عامي 2000، 2005م وحدهما. كما لا يزال ضمان مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي مقبولة يمثلان تحديين تواجههما إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بقضية تغير المناخ. يؤثر تغير المناخ سلبًا على الزراعة في إفريقيا، ورغم ذلك، تعاني القارة بالفعل من نقص غذائي. إذا لم يعالج تغيُّر المناخ بجدية، فمن المتوقع أن ينخفض إنتاج الذرة والقمح في جنوب إفريقيا بشكل كبير بحلول عام ٢٠٣٠م. وبالتالي، أصبحت مسألة الاستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية شاغلًا رئيسيًا للعدالة الاجتماعية في إفريقيا.
يتميز الكتاب بعدة مميزات، من أهمها ما يلي:
- شمول الطرح وتعدُّد المحاور: حيث يغطي جوانب متعددة من الواقع الإفريقي (اقتصادية، سياسية، اجتماعية).
- سلّط الكتاب الضوء على قضايا رئيسية تمثل تحديات للقارة الإفريقية كالتعليم والصحة وتنظيم الأسرة، والهجرة والجوع والفقر، كما سلط الضوء على أثر الإرث الاستعماري على المشكلات التي تواجهها القارة.
- قدَّم الكتاب تحليلًا رائعًا حول أسباب تقدُّم آسيا وتأخُّر إفريقيا في أثناء الحرب الباردة من خلال تحليل الدور التنموي الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي.
- استند الكتاب إلى أمثلة واقعية من عدة دول إفريقية كنماذج حالة مثل الكاميرون وكينيا، كما قدَّم مقارنة بين الدول الإفريقية مما يُثري المناقشة.
- استخدم المؤلفان التحليل التاريخي المتماسك الذي يُعيد ربط الماضي بالحاضر.
- استخدم المؤلفان الأسلوب الأكاديمي الرصين الذي يجمع بين الدقة والوضوح.
عيوب الكتاب:
- عدم التوازن في تناول القضايا: إذ كان التركيز على السياسة والاقتصاد أكثر من الثقافة والبيئة.
- نقص في الأمثلة الميدانية المفصلة: خاصةً في موضوعات مثل التعليم أو الصحة.
- بعض التكرار في التحليلات: خصوصًا فيما يتعلق بانتقاد الفساد السياسي أو الممارسات الاستعمارية.
- لم يستخدم المؤلفان النقد كمنهجية ضرورية للكتاب؛ حيث إن حالات النقد في الكتاب تكاد تكون ضئيلة.
الخلاصة:
يُعدّ الكتاب مساهمة فكرية قيّمة لفهم القارة الإفريقية في مرحلة ما بعد الاستعمار، لما يَحمله من رؤية نقدية عميقة وتحليل واسع النطاق للمشكلات التي واجهتها، وما زالت تواجهها القارة الإفريقية. يجمع الكتاب بين الطرح التاريخي والسياسي والاقتصادي، ما يجعله مرجعًا مهمًّا للباحثين والمهتمين بالدراسات الإفريقية والتنموية.
لكن بالرغم من هذا الزخم، فإن بعض المحاور افتقرت إلى التحليل السوسيولوجي. ومع ذلك، فإن الكتاب ينجح في لفت الانتباه إلى ضرورة تحرير السياسات الإفريقية من التبعية والفساد، والدفع نحو تنمية أصيلة وفاعلة.
يُوصِي الكتاب، في مجمله، بضرورة بناء إفريقيا من الداخل، والابتعاد عن الخطابات الإنشائية، مع التشديد على التعليم الجيد، وتحسين قطاع الصحة وتحقيق عدالة اجتماعية، وتفعيل دور المرأة والشباب، والحدّ من هجرة الكوادر العلمية.
……………………………..
[1] – Falol, Toyin & Mbah, Emmanuel M. (2014). Contemporary Africa: Challenges and Opportunities. United States: Palgrave Macmillan.












































